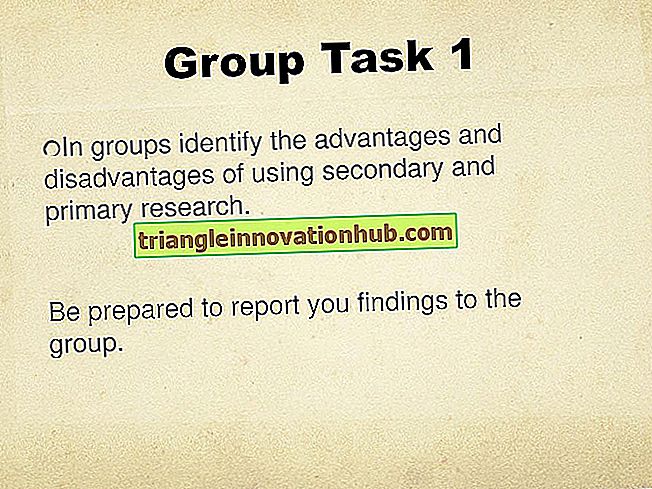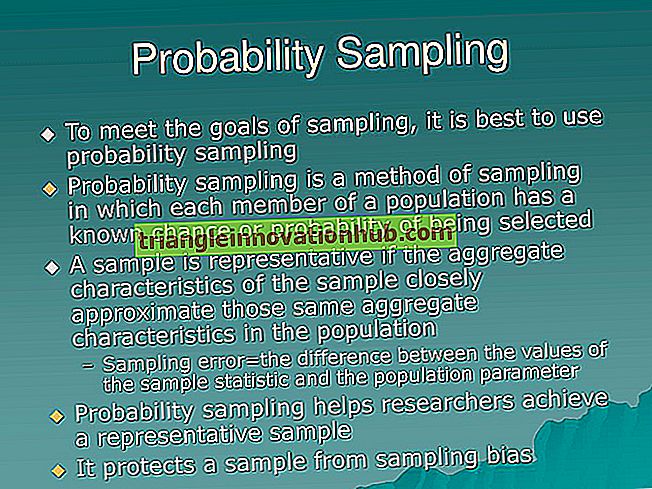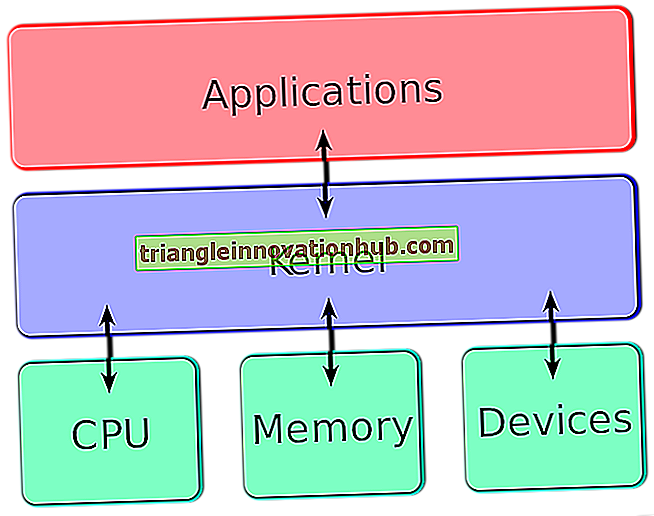صلة تاريخ البحث الاجتماعي
بعد قراءة هذا المقال ، ستتعرف على أهمية التاريخ للبحث الاجتماعي.
لقد حاولت مجموعة من المفكرين ، خلال الفترة الوجيزة نسبيًا التي تم فيها الاعتراف بالعلوم الاجتماعية كشكل منضبطة من المسعى الفكري ، أن تؤثر في التمييز الصارم بين ما يُعرف تقليديًا بالعلوم الاجتماعية ، مثل علم الاجتماع والاقتصاد من جهة ، و التاريخ من ناحية أخرى ، من حيث منطقهم وطريقتهم.
لقد جادلوا بأن التاريخ هو في الأساس "انضباط تشخيصي" ، في حين أن العلوم الاجتماعية ، عمومًا ، هي "اجتماعية".
وبصورة تعريفية ، فإن مصطلح الهوية ، مثل التاريخ ، يهتم بالأحداث الفريدة والخاصة أو الأحداث التي تدرس من أجل مصلحتهم الخاصة ، في حين تهتم الاختصاصات التقويمية مثل علم الاجتماع بالأحداث الفريدة والخاصة التي تتم دراستها لذاتها ، بينما يهتم التلاميذ المتغيرون مثل علم الاجتماع بالأحداث أو الأحداث الفريدة والخاصة التي تتم دراستها لمصلحتهم ، في حين تهتم الاختصاصات التقويمية مثل علم الاجتماع بصياغة المبادئ العامة التي يتم من خلالها البحث عن طبقة الظواهر التي تشكل موضوعها. أن يتم فهمه.
هذه النظرة ثنائية التفرع للعلوم التي غالباً ما أشارت إليها مجموعة من المؤرخين ، وعلماء الاجتماع الذين يرغبون بشدة في الحفاظ على بعض الخط الفاصل الواضح بين مجالاتهم.
وقد تم استكمال الحجة الرئيسية من خلال فرعين مستمرين إضافيين بين هذه التخصصات. على سبيل المثال ، يقال أن عالِم الاجتماع في سعيه للحصول على مقترحات عامة حول الأنظمة الاجتماعية ، بالضرورة ، يجب أن يطور مخططات مفاهيمية حتى يكون قادراً على تحليل وترتيب العديد من التنوعات للوجود الإنساني في المجتمع.
يدير المؤرخ هذه الحجة ، كما هو مع الأفراد والأحداث في تفاصيلها الخاصة ، ولا يملك سوى القليل ، إن وجد ، لاستخدامه لمثل هذه التصورات المفاهيمية للتطبيق العام. في جوهرها ، يتم التفكير في عالم الاجتماع والمؤرخ على أنها تعمل على مستويات مختلفة من الاهتمام بالتجريد.
لتتبع المثال مزيد من التمييز بين اثنين من التخصصات كما أوضحت من قبل مجموعة من المفكرين الذين يتبنّون وجهة النظر الثنائية ، يتعلّقون بالدور الذي يلعبه بعد الوقت في كلا المجالين.
يعمل المؤرخ ، من هذا المنطلق ، على تتبع تسلسل زمني للأحداث الماضية ، يظهر كيف أدى حدث ما إلى حدث آخر ، في حين أن علم الاجتماع على النقيض من ذلك ، يهتم بشكل رئيسي بالعلاقات الوظيفية الموجودة بين عناصر مميزة تحليلية في المجال الاجتماعي. نظم الوقت بغض النظر.
وينظر إلى عالم الاجتماع على أنه يسعى إلى افتراضات عامة لا ترتبط بالسياق الزماني أو الحيزي ، أي زمان وفضاء أقل.
وهناك حجة أخرى في التحليل النهائي إلى النهاية نفسها ، تقدمت بشكل أساسي من قبل علماء الاجتماع الذين يحرصون على حراسة "وضعهم المكتسب حديثا" كعلماء وتأثير ذلك التاريخ وعلم الاجتماع في إجراء تحقيقاتهم.
علماء الاجتماع وفقا لهذا الرأي ، اتبع أساليب العلوم الأساسية الصلبة في حين لا التاريخ ، والجزء الأكبر لا يمكن أن نتطلع إلى هذا بسبب طبيعة الموضوع نفسه. يجب عليه أن يكتفي بالطرق التي لا تتوفر إلا في النتائج الأقل جودة.
ومع ذلك ، فإن رسم خطوط متشددة للتمييز بين التاريخ وعلم الاجتماع (كعلم اجتماعي) ، كما حصل مع مجموعة من المؤرخين وعلماء الاجتماع ، قد ينطوي على صعوبات كبيرة. لقد أظهر ناجيل بشكل مقنع أن التمييز بين التخصصات النموذجية والتقليدية هو الذي لا يمكن ، في نهاية المطاف ، الاحتفاظ به.
من الصعب أن نقدر كيف يمكن للمرء أن يحصل في معرفة نمطية محض على معرفة بأي شيء على الإطلاق. ومن ناحية أخرى ، لا يمكن تجنب أي اعتبار للفرد المفرد أو الخاص أو غير المتكرر في مجال تخصصي.
أي محاولة للتمييز بين التاريخ وعلم الاجتماع على أسس منهجية مشحونة بالمثل مع العقبات. وهذا يعني ضمناً أن علم الاجتماع يجب أن يكون مقيدًا فعليًا بدراسة المجتمعات الحالية ، هنا والآن. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحديد نطاق الانضباط بالرجوع إلى مجموعة معينة من تقنيات البحث.
وهكذا يمكن النظر إلى الحجج التي قُدمت لصالح الفصل الصارم بين التاريخ وعلم الاجتماع على أنها تنطوي على نتائج مثيرة للقلق بالنسبة إلى تقدير علماء الاجتماع لاستخدامات البيانات التاريخية في مجالات أبحاثهم الخاصة.
إذا التزم علماء الاجتماع بالرأي القائل بأن التاريخ وعلم الاجتماع مختلفان منطقياً أو منهجياً ، فسيكون من المفهوم أن يكون لديهم تقدير منخفض لأهمية التاريخ في مجالات دراستهم.
باعتراف الجميع ، بالنسبة لعلم الاجتماع الذي يفكر في المهمة الرئيسية لعلماء الاجتماع كطبقة ، وبناء نظرية عامة للنظم الاجتماعية على أساس مجموعة من المجموعات المجردة منطقية ، قد لا تبدو المواد التاريخية بشكل عام ذات قيمة كبيرة. قد تكون ، بالطبع ، ذات أهمية خاصة له في إحترام واحد فقط ، أي فيما يتعلق بالجوانب الديناميكية لنظريته العامة أو عبر التاريخ المزعومة.
ليس من الصعب رؤية أن البيانات التي يتم تأمينها من خلال الأساليب التقليدية للمؤرخ الذي يمتلك استمرارية مع مرور الوقت ، مطلوبة لتطوير واختبار الافتراضات العامة حول عملية التغيير الاجتماعي على المدى الطويل.
في الواقع ، كما يقول هانز غينث ، "إن التاريخ يتكون من التغييرات التي يخضع لها الهيكل الاجتماعي". كل تغيير ، يظهر كل واحد منهم مثل الفيلسوف وايتهيد ، "هو ... يحتوي في ذاته كل ماضيه وبذرة مستقبله".
تشهد دراسة سملسر بعنوان "التغيير الاجتماعي في الثورة الصناعية" ، بشكل لا لبس فيه ، إلى مدى جودة استخدام البيانات التاريخية من قبل عالم اجتماع مهتم باختبار المقترحات العامة حول عملية التغييرات الاجتماعية طويلة الأجل.
يستخدم Smelser قدرًا كبيرًا من البيانات من التاريخ الصناعي والاجتماعي في Lancashire التي تغطي فترة تزيد عن سبعين عامًا بدءًا من عام 1770 ، بهدف توفير اختبار تجريبي للنظرية العامة للتغيير في الأنظمة الاجتماعية من خلال عملية التمايز البنيوي.
النظرية جزء من النظرية الأوسع للعمل الاجتماعي التي طورها تالكوت بارسونز. إن الإجراء الذي اتبعه سميسلر هو إظهار كيف يمكن تطبيق نموذج التغيير البنيوي بنجاح على التغيير:
(أ) في صناعة القطن في لانكشاير ثم ، للتغيير ،
(ب) في الاقتصاد الأسري للطبقة العاملة في لانكشاير ، يوجد نظامان مؤسسيان مختلفان بشكل ملموس. يقول سميسلر إن كلا النظامين الفرعيين يتطابقان مع نفس نمط التمييز البنيوي وعملية التغيير ، وفي كلتا الحالتين يمكن تفسيرهما من حيث نموذج ديناميكي مشترك.
وهكذا ، زعم سملسر التطبيق العام للنموذج وبصورة عامة من النظرية العامة للعمل التي اشتُق منها النموذج. بهذه الطريقة ، استخدم <سملسر> بيانات التاريخ كنوع مفيد من المواد لحقن المحتوى في سقاله النظري التاريخي.
لم يكن مهتمًا بصناعة قطن لانكشاير أو عائلة الطبقة العاملة لمصلحتها الخاصة ، ولا حتى في سياق بعض النظرية الأوسع لعملية التصنيع ، بل كان مهتمًا بهذا ببساطة لأنها قدمت بيانات يمكن استخدامها في اختبار النظرية العامة للنظم الاجتماعية.
بالنسبة لـ Smelser ، لم تكن تواجد المنظومتين الفرعيتين تاريخياً. بالنسبة لمجموعة علماء الاجتماع التي تشدد على الفرق المنهجي الأساسي بين التاريخ وعلم الاجتماع ، لا تزال البيانات التاريخية ذات أهمية ضئيلة مقارنة بما قد يكون لدى علماء الاجتماع الذين يتعاملون مع نظريات النطاق العام.
في حين أن هذه المجموعة قد تمنح بعض الاعتراف بقيمة التوجه العام لقيمة الاتجاه العام للدراسات التاريخية الواسعة لعلماء الاجتماع (بالنسبة لمن يستطيع أن ينكر القاعدة التاريخية القوية الكامنة وراء التفكير الاجتماعي لماركس ، ويبر ودوركهايم) ، فإن التأريخ التقليدي يعتبر تمثيلاً لبعض أسلوب التفكير المعياري حول الإنسان والمجتمع الذي يتفوق بوضوح في دراسة المجتمعات المعاصرة التي تتم بمساعدة تقنيات البحث "الحديثة".
بالنسبة لهم ، فإن الأساس التجريبي للحجة التاريخية الكثيرة هو المشكوك فيه. انتقد لازارسفيلد بعبارات قوية التأكيدات الكثيفة التي كثيراً ما أدلى بها المؤرخون دون أساس تجريبي كافٍ.
لن يستفيد الأصوليون المنهجيون ، قدر الإمكان ، من النوع التقليدي للمواد التاريخية حتى فيما يتعلق بدراسة التغيير الاجتماعي ؛ يفضلون إنشاء نوع خاص بهم من البيانات التاريخية باستخدام تقنيات مثل دراسة اللوحة. فقط هكذا ، قد يجادل ، هل يمكن الحصول على بيانات نوعية تحليلات نظرية مثمرة.
إضافة إلى ذلك ، فإن مجموعتين من علماء الاجتماع المذكورين سابقاً ، والتي تعتبر صلة البيانات التاريخية بها أكثر قليلاً من الهامشية ، توجد مجموعة رئيسية تمثل ما يمكن تسميته بالتقاليد "الكلاسيكية". تأخذ هذه المجموعة موقفًا مختلفًا تمامًا في ما يتعلق بتاريخ البحث الاجتماعي.
ينبع هذا التقليد من الإيمان بأن دراسة التاريخ هي واحدة من أهم مصادر البيانات الاجتماعية. تتميز الاستفسارات الاجتماعية التي تتبع هذا التقليد بالتركيز على الأشكال المختلفة للهيكلية والثقافة التي تعرضها مجتمعات معينة في نقاط محددة من تطورها أو تطورها وعلى فهم عمليات التغيير المحددة المحددة في المصطلحات الجغرافية والتاريخية.
هذه المجموعة من علماء الاجتماع ، تعمل ، لاستخدام عبارة رايت ميلز ، على مستوى الهياكل الاجتماعية التاريخية. كبار سادة التقليد الكلاسيكي في علم الاجتماع ، على سبيل المثال فقط الأكثر تميزا ، هم كارل ماركس ، ماكس ويبر ، هربرت سبنسر ، مانهايم ، شومبيتر ، موسكا ، ميشيلز ، فيبلين ، هوبسون و سي رايت ميلز.
إن وجهات نظر علماء الاجتماع "الكلاسيكيين" هي بالتأكيد أوسع نطاقاً مقارنة بمنظور علماء الاجتماع الذين سيسمحون للأساليب الحديثة للبحث الميداني بتعريفهم بنطاق موضوعهم.
وهكذا يمكن النظر إلى التقليد الكلاسيكي في علم الاجتماع على أنه مكان متوسط في سلسلة أنواع الاستفسار المختلفة التي تشكل علم الاجتماع الحديث. لا يهدف علماء الاجتماع في هذا التقليد إلى وضع نظرية عامة كاملة ، ولن يكونوا راضين عن مجرد أوصاف تجريبية للوسط الاجتماعي في وقت معين.
يتمثل الشاغل الرئيسي لتلك التقاليد "الكلاسيكية" في استيعاب التنوع الذي يتجلى في بنية المجتمعات وثقافتها ، مع تحديد حدود ومحددات هذا التنوع وشرح كيف تطورت المجتمعات أو الهياكل في داخلها طريقة معينة وتعمل بالطريقة التي يقومون بها.
وهذا ينطوي على التفكير فيما يتعلق بالمجتمعات التي تقوم بتطوير الهياكل ، ومن هذا المنطلق يدعو إلى إدخال بعد تاريخي. وبالتالي ، فإن الصلة الخاصة للبيانات التاريخية لعلماء الاجتماع من هذه المدارس هي موضع تقدير بسهولة.
من الواضح أن أي نهج تنموي لا يمكنه الاستغناء عن المواد التاريخية. عندما يتحدث المرء عن التغيير من المجتمع الشعبي إلى مجتمع حديث أو من التنظيم الرسمي إلى الإنتاج الرسمي أو الأعمال التجارية ، فهو يستخدم في الواقع المفاهيم التي تستمد صحتها من الدراسة التاريخية.
الطريقة المقارنة ، الأساسية للتقليد الكلاسيكي تجذب أنفاسها من التاريخ. ويتكون النهج في المقارنة بين مختلف المجتمعات بهدف تفسير التباين في البنية الاجتماعية والثقافة. هذه المقارنة تشمل أو يجب أن تشمل ، من حيث المبدأ ، مجتمعات الماضي وكذلك الحاضر.
لا يمكن لأداة الأسلوب المقبول أن تتجاهل الصندوق الهائل من المعلومات حول الإنسان والمجتمع الذي يقدمه الماضي ، بغض النظر عن المواد المتوفرة في المجتمعات المعاصرة. بالنسبة له ، فالتاريخ هو المجال الأوسع وربما أيضًا أغنى مجال للدراسة.
ووفقاً للتقليد الكلاسيكي ، فإن علم الاجتماع الساري في الواقع لا يقل عن الانضباط التاريخي ولا يمكن التعامل مع مشاكل اهتمامه أو صياغته بشكل مثمر دون تبني منظور تاريخي واستخدام واسع النطاق للبيانات التاريخية.
وهكذا ، فإن التقليد الكلاسيكي يرفض الاعتراف بأي ترسيم واضح من أي نوع بين التاريخ وعلم الاجتماع. وينظر إليها على أنها متشابكة بشكل لا ينفصم أو تدمج بشكل غير محسوس ، واحدة في الأخرى. يعتبر هذا التقليد الاختلافات بينهما كاختلافات في الدرجة فقط ، وليس من النوع.
تتيح المناقشة المذكورة أعلاه تراجعًا إدراكيًا لمسألة أهمية التاريخ للدراسات الاجتماعية.
هناك من ناحية ، علماء الاجتماع الذين يأخذون "وجهة نظر العلوم الطبيعية" في علم الاجتماع ، بغض النظر عن تركيزهم على الاهتمام ؛ صياغة نظرية عامة أو بحث اجتماعي تجريبي باستخدام تقنيات كمية ، وهناك من ناحية أخرى مجموعة قوية ملتزمة بالتقاليد الكلاسيكية وتعمل على مستوى الهياكل الاجتماعية التاريخية. بالنسبة إلى الأول ، فإن أهمية التاريخ للدراسات الاجتماعية لا تكاد تذكر أو هامشية ، بينما بالنسبة إلى الأخير ، فإن علم الاجتماع متأصل حتمًا في دراسة التاريخ.
يزعم الأول أن العلم الحقيقي للمجتمع يجب أن يكون قادرًا على تجاوز التاريخ ، من الناحية النظرية والطرق ، في حين يجادل الأخير بأن التاريخ لن يتم تجاوزه. وكما قال ماركس ، "إن التاريخ الحقيقي ، التاريخ كنظام زمني ، هو الخلافة التاريخية التي تجلت فيها الأفكار والفئات والمبادئ ... إنها المبدأ الذي (يجعل) التاريخ ، وليس التاريخ ... المبدأ".
إنهم (الأخيرون) يتساءلون عن قيمة كل من المحاولات لإقامة نظرية عبر التاريخ والدراسات التجريبية التفصيلية للوسط الاجتماعي التي تتجاهل السياقات المجتمعية والتاريخية.
على الرغم من أن هذا الجدل (الذي تلاشى تدريجياً في السنوات الأخيرة) يصعب تقييمه ، فإنه يمكن أن يقال مع قدر معين من الاقتناع بأنه لن يكون من المجدي أن يستبعده المنهجيون المنهجيون من خريطة الانضباط الاجتماعي وهذه الدراسات التي لا تأتي إلى المعايير المنهجية بشكل صريح من صلاحية ودقة ولا لهذه المسألة سيكون من المرغوب فيه أن التقليديين "الكلاسيكية" لإنكار ملاءمة الأساليب الكمية الحالية في البحوث الاجتماعية على النتائج المترتبة مشاكل اجتماعية.
ينشأ الاستيراد الحقيقي للحجة حول أسئلة حول كيفية توجيه علماء الاجتماع للجيل الحالي بشكل أفضل لجهودهم ومواردهم. لا يمكن لأحد أن ينكر أن الدراسات على الخطوط "الكلاسيكية" ذات أهمية حاسمة لعلم الاجتماع المعاصر وينبغي متابعتها بحماس ، في المصلحة الأكبر للموضوع.
يجب على أي نظرية عامة مقترحة أن تأخذ بعين الاعتبار ، بشكل مفهوم ، مدى الاختلافات المحتملة في المجتمعات البشرية ، لا سيما الطرق التي يتم بها دمجها وتغييرها. وقد انتقدت النظرية العامة لبارسونيان على درجة أنها ليست عامة كما يزعم ؛ أي أن بعض الاختلافات أو الاستثناءات التي تظهرها بعض المجتمعات قد عانت من الإهمال في مخططه النظري.
لا يحتاج الأمر إلى التأكيد المفرط على أن دراسات النوع التاريخي والمقارن تفي بوظيفة العمل كأطر يمكن من خلالها إجراء دراسات تجريبية تفصيلية للملحن الاجتماعي بطريقة ذات معنى.
سيكون الإجراء الأكثر مكافأة هو الدراسة بمساعدة تقنيات بحثية حديثة خاصة بالبيئة الاجتماعية والتي يبدو أنها ذات أهمية خاصة في سياق بعض التحليل البنيوي الأوسع.
من السهل أن نقدر كذلك أن الدراسات التي تركز على أنماط التباين في البنية الاجتماعية أو على ما يؤخذ على أنه "طبيعة بشرية" ، يمكن أن تكون مساعدة كبيرة في فهم مجتمعنا والأوقات التي نعيش فيها. تساعدنا الإعدادات عادة على فهم وضعنا بشكل أكثر تفهماً. ومن ثم ، فإن تقليد الدراسة ذات التوجه التاريخي سيستمر في تشكيل جوهر علم الاجتماع.
خلال العقود القليلة الماضية ، تم الاعتراف بأهمية المنظور التاريخي إلى حد كبير من قبل المعسكر المتنافس الذي يمثل "وجهة نظر العلوم الطبيعية في المجتمع". في الواقع ، كان على هذا الربع من علماء الاجتماع مواجهة وابل من الانتقادات من داخل الانضباط نفسه. وقد اتخذت مواقف حرجة على نحو متزايد تجاه كل من "النظرية العامة" وطرق البحث الاستقصائي في السنوات الأخيرة.
لقد تم التشكيك بجدية في قيمة النظرية الهيكلية الوظيفية العاملة على فرضية النظام الاجتماعي. وبينما أظهرت السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في معدات التحليل الكمي ، فإن صلاحية البيانات الخاضعة لهذه التحليلات قد خضعت للفحص البحثي.
نتيجة هذه التطورات وفقا ل Goldthorpe هو أن مفهوم العمل الاجتماعي قد اتخذت مركزية جديدة ، سواء من وجهة النظر المنهجية والنظرية. أصبحت الحاجة إلى شرح البنية الاجتماعية من حيث العمل وتفسير معنى العمل مرة أخرى الشغل الشاغل للتحليل الاجتماعي.
مع هذا التطور ، تقلص الفراغ بين وجهات نظر المؤرخين وعلماء الاجتماع إلى حد كبير ، ومرة أخرى ، اقتربت إمكانية إجراء حوار متبادل ذي مغزى بين النظامين ، نموذجي في زمن ماكس ويبر ، من التجسيد.
شهدت العقود السابقة تطوير أشكال جديدة من التاريخ الاجتماعي (أو "التاريخ الحضري") تم بناؤها من أجسام كبيرة من البيانات الكمية المضمونة من مصادر مثل السجلات الرسمية ، أدلة التجارة وتقارير التعداد ، إلخ. وبالتالي لا يوجد أساس حقيقي الآن ، لتمييز المؤرخين من علماء الاجتماع بالرجوع إلى أنواع البيانات التي يعمل بها العملان والطريقة التي يستخدمونها بها.
يُطلب من المؤرخين في الاضطرار إلى التعامل مع مثل هذه البيانات (التاريخ الاجتماعي) أن يعتمدوا بشكل كبير على تقنيات التحليل التي طورها علماء الاجتماع بشكل رئيسي. عليهم أيضا أن يعتمدوا على المفاهيم الاجتماعية التي بدأوا بتقديرها. وبالمقابل ، فإن التاريخ الاجتماعي الجديد له وظائف هامة بالنسبة لعلماء الاجتماع.
وقد شجع تظاهرة البيانات التاريخية باعتبارها سلالة منتظمة وكمية كما هو واضح في التاريخ الاجتماعي الجديد علماء الاجتماع على استخدام مثل هذه المواد لاختبار فرضيات محددة تنطوي على مقارنات كمية.
ومن ثم ، فإن التاريخ الاجتماعي الجديد هو نظير مرحب به لعلماء الاجتماع لإجراء تحقيقات تجريبية حول نظريات معينة في النطاق المتوسط تتعلق بالآثار طويلة الأجل لعملية معينة على آليات وعمليات مؤسسية أخرى.
يتميز علم الاجتماع المعاصر باهتمام متجدد بالآفاق الاجتماعية الكونية والتطورية أو التنموية ، وهذا التطور بالتحديد هو الذي يدعو إلى موقف حذر ونقدي تجاه البيانات التاريخية. لا سيما أن علماء الاجتماع الساعين للعمل في التقليد الكلاسيكي يجب أن يكونوا مدركين للحاجة إلى اعتماد بيانات تاريخية من المصادر الثانوية مع قليل من الملح.
من الواضح أن كتاب هذا التقليد الذين صرخوا ضد علماء الاجتماع "الوضعيين" الذين يعتمدون بشكل كامل على البيانات المستندة إلى الدراسات الاستقصائية هم أنفسهم يُظهرون قدراً من الدوغمائية في معالجة "الحقائق" الواردة في الأعمال التاريخية كحقائق بديهية بدلاً من فهمهم بشكل رئيسي في طبيعة الاستدلالات من المؤرخ المستمد من "الآثار" تحت تصرفه.
يحتاج أي نوع من علم الاجتماع التاريخي المعتمد بشكل أساسي على المصادر التاريخية الثانوية إلى تطبيق مسامير التدقيق النقدي بنفس الطريقة التي تتطلبها منهجية علم الاجتماع الموجه كمياً.
يبدو أن بعض النسخ من علم اجتماع اليوم الحالي باستخدام النهج التطوري أو التنموي تكشف عن قدر من عدم اليقين فيما يتعلق بالعلاقة بين البيانات التاريخية والنظرية.
الهدف في مثل هذه الدراسات هو التمرين الجيد للتظاهر تجريبيا ، على أساس الأدلة التاريخية ، بعض الأنماط المتسلسلة في التغيير المؤسسي أو الهيكلي. لكن إجراء تتبع الأنماط التاريخية بعد الحادثة ، لا يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى تفسير نظري.
ينطوي التفسير النظري على ممارسة منفصلة. هناك أدلة على بعض المحاولات الأخيرة لإنتاج التاريخ "النظري" ، أي نظريات التطور أو التطور الاجتماعي التي تدعي أنها تمثل المبادئ الكامنة وراء التتابع المتسلسل ، وبالتالي ، تحمل تقديرات حول المستقبل.
تنعكس هذه المحاولات بوضوح في أعمال الكتاب الماركسيين "الجدد" مثل بيري أندرسون ، وقد ثبت أنها حاضرة ، وإن كان ذلك سراً ، في معظم الكتابات الأمريكية الحالية حول موضوعات التحديث والتصنيع.
في آخر عمل لبارسونز ، هناك محاولة من هذا النظام يمكن ملاحظتها (إحياء النظرية الوظيفية البنيوية بالارتباط مع نظرية التطور المؤيدة للطبيعة). في كل هذه المحاولات ، هناك بحسب غولدثورب ، ميل إلى تجاهل الانتقادات المنطقية الموجهة ضد فكرة التاريخ النظري من قبل مؤلفين مثل كارل بوبر وجيلنر.
ويسعى مؤلفو هذا السبيل المنهجي ، حسب قوله ، إلى "الأسلوب التاريخي الكلاسيكي ، لاستخدام نظرياتهم لإعطاء أساس علمي زائف وموضوعية لما يمكن أن يظهر في الحجج الإيديولوجية".
إن نظريات التطور الاجتماعي والتنمية وفقًا لروبرت نايسبت ، عادة ما تكون "مسكونة" بمشكلة كيفية جعل السجل التاريخي متطابقًا مع عمليات التغيير الرئيسية المقترحة.
إن الإدراك الحكيم بالسجل التاريخي والطريقة التي يتم بناؤها من شأنه أن يقف على عاتق علماء الاجتماع في وضع جيد ، لأن مثل هذا الإدراك قد يكون من المتوقع أن يحسسهم بالمواقع الغادرة التي قد تكون مخبأة في النظريات التطورية كطبقة.
وهكذا ، في حين اتفق مع آرثر شليزنجر على أنه "لا يمكن لأي عالم اجتماعي أن يتجاهل بحكمة ذراع الماضي الطويلة" لا نحتاج إلى الاتفاق مع دانيال ويبستر على أن "الماضي ، على الأقل آمن". قد يؤدي الاعتقاد البديهي عن كونك آمنًا في الماضي إلى واحد لاستنتاجات الغادرة. إن أي موقف حاسم وحذر إزاء المواد التاريخية ، هو أمر مرغوب فيه.