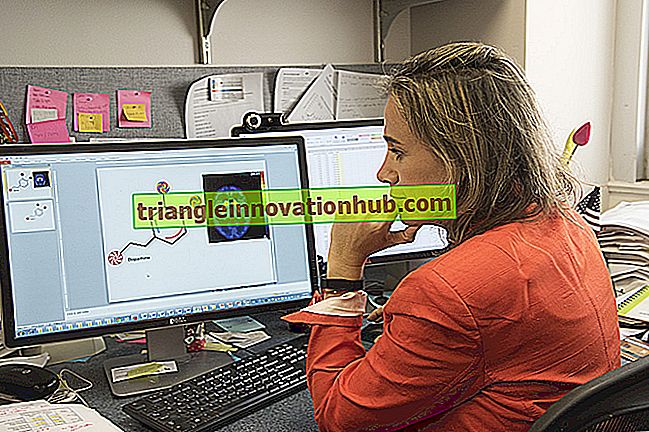الديمقراطية وتأثيرها على مستقبل الحكم العالمي
إن نمو المخاطر العالمية يغير بسرعة سياق الحكم. ويبدو أن نمو هذه المخاطر يمثل أهم تغيير اجتماعي يؤثر على علاقة الدولة بالمجتمع المدني.
في حين أن الدولة متورطة بشكل كامل في خلق مثل هذه المخاطر ، على سبيل المثال من خلال بحثها عن أسلحة أكثر تدميراً وترويجها للتحرير الاقتصادي الذي أدى إلى عدم مساواة عالمية وتدهور بيئي ، تظل الدولة أيضاً هي الفاعل السياسي قادرة على مواجهة مثل هذه المخاطر. إذا كانت إدارة المشاكل العالمية فعالة ، يجب على الدول أن تتصالح مع تقاسم سلطتها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والمجتمع المدني العالمي الناشئ.
في هذا المقال ، أوضحت هذه الحجة من خلال توضيح بعض نقاط ضعف نظرية العلاقات الدولية ، وهو الانضباط الأكاديمي الأكثر اهتماماً بالسياسة العالمية. إن العديد من افتراضاتها ، خاصة فيما يتعلق بطبيعة سيادة الدولة وأمنها ، هي حواجز تحليلية تعوق فهم الحقائق المعاصرة للسياسة الدولية ، والتي تتشكل بشكل متزايد من خلال معضلات أمنية جديدة لم تعد تستطيع فرادى الدول إدارة شؤونها بفعالية.
إن المؤسسات المستدامة للحكم العالمي في مرحلة مبكرة ، وليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن المجتمعات المتنوعة ستكون قادرة على العمل معاً بفعالية لمواجهة تحديات المخاطر العالمية. ومع ذلك ، فإن نظريات الديمقراطية الكوسموبوليتانية تبعث على الأمل في أن تؤدي الاتجاهات الواضحة نحو تعاون عالمي أكبر إلى خلق إمكانية لشكل جديد من الحكم يتحرك تدريجياً إلى ما بعد الدولة. سوف تختتم المقالة بنقاش حول الديمقراطية الكونية وتأثيراتها على مستقبل الحكم.
نظرية العلاقات الدولية والمخاطر العالمية :
تهتم نظرية العلاقات الدولية بالقوى التي تشكل السياسة خارج حدود الدول الفردية. في فترة ما بعد الحرب ، كانت السمة النظرية المهيمنة داخل الانضباط هي الواقعية. بالنسبة للواقعيين ، الدولة هي الفاعل الأساسي في الشؤون العالمية. إنه صراع بين الدول ، من أجل السلطة والأمن يحدد طبيعة السياسة العالمية. بالنسبة للواقعيين الكلاسيكيين ، مثل Morgenthau (1948) ، فإن الصراع هو سمة دائمة في نظام الولايات لأنه خاصية دائمة الوجود للطبيعة البشرية.
أفضل ما يمكن أن نأمله هو احتواء هذا الصراع من خلال بناء تحالفات استراتيجية بين الدول. ويمكن تحقيق ذلك من خلال السعي إلى الدبلوماسية والقوى العظمى التي تتصدر دورها في ردع استخدام الدول المارقة للقوة. الصورة يرسم Morgenthau دهانات العلاقات الفوضوية للنظام الدولي مشابهة لنظرية هوبز عن حالة الطبيعة ، والتي تصف عدم الأمان في مجتمع بلا دولة. بالنسبة إلى هوبز (1973) ، فإن الأفراد ، مثل الولايات ، يدفعهم السعي وراء المصلحة الذاتية ، وبالتالي هناك دائمًا احتمال ما وصفه هوبز بأنه "حرب الكل ضد الكل".
لا يمكن منع ذلك إلا إذا قام الأفراد بعقد مع قوة أعلى لحمايتهم من بعضهم البعض. غير أن التشابه بين نظام الدول والتفاعل بين الأفراد يقال من قبل الواقعيين على أنه محدود: فالدول تتمتع بعمر أطول مما يفعل الأفراد لأنه لا يمكن تدميرها بسهولة من خلال عمل القوة ، وستقاوم الإغراء. للتوقيع على استقلالهم لسلطة أعلى.
لذا فإن الحكم العالمي هو وهم يوتوبي ينكر حقيقة سيادة الدولة ، التي تظل حجر الزاوية في الشؤون الدولية. السيادة إذن هي المفهوم الأساسي للواقعية. يؤخذ على هذا النحو أن الدول تتمتع بالسلطة القضائية دون منازع داخل حدودها الخاصة. يحاول الواقعيون القيام بمحاولات قليلة لوضع تصور عن تأثير علاقة الدولة بمجتمعها المدني على علاقاتها مع الدول الأخرى.
ويعرب فالتز عن هذه النظرة الساذجة عندما يكتب أن "طلاب السياسة الدولية سيحسنون التركيز على نظريات منفصلة عن السياسة الداخلية والخارجية حتى يتعرف شخص على طريقة لتوحيدهم" (كما ورد في روزنبرغ ، 1994: 5). يستطيع الفالز أن يجادل في هذا بسبب نظرته لكيفية عمل نظام الدول. يرفض والتز (1979) تفسيرات الصراع الدولي التي تشدد على الطبيعة البشرية.
بل هي بنية النظام الدولي الذي يخلق التوتر بين الدول: في غياب سلطة أعلى ، تتنافس الدول مع بعضها البعض لضمان أمنها. قد يؤدي هذا إلى حدوث سباق تسلح ، وربما يؤدي إلى حرب شاملة. سيحدد هذا الهيكل السياسة الخارجية للدولة ، بغض النظر عن ترتيباتها السياسية الداخلية أو طبيعة نظام الاعتقاد السائد في المجتمع المدني.
قوة الواقعية هي أنه يسلط الضوء على اللاعقلانية التي ترتكز على منطق عالم مقسم إلى دول. إن الصراعات بين الدول ، والتي يتم توثيقها بشكل جيد من قبل التاريخ ، والتي غالباً ما تتجاوز الصفات المشتركة الواضحة لـ "العرق" أو الأيديولوجية ، تقدم أدلة دامغة تدعم الحجة الواقعية. لكن من الواضح بشكل متزايد أن الافتراضات الواقعية غير كافية لمهمة شرح طبيعة السياسة العالمية المعاصرة. تكمن مشكلة النظرية السائدة للعلاقات الدولية في فهمها لسيادة الدولة وأمنها.
كانت سيادة الدولة أساس نظام الدول منذ أن وضعت معاهدة ويستفاليا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في عام 1648. إن الصورة الواقعية الكلاسيكية لنظام الولايات هي عدد من كرات البلياردو المستقلة والصلبة. التي تصطدم أحيانًا وتكون غير قادرة على بناء مصالح مشتركة تتجاوز تلك التي تمليها عقيدة المساعدة الذاتية. ومع عولمة المخاطر ، فإن هذا المفهوم المجرد للسيادة يمثل إشكالية متزايدة.
إن صورة كرة البلياردو الصلبة تفسح المجال لاستعارة الدولة "المجوفة" ، حيث أن القوى الخارجة عن الدولة وتحتها تهدد مطالبها بالسيطرة على الأراضي. ومع ذلك ، فإن الدولة لا تزال فاعلة قوية ومفهوم دولة "مجوفة" هو استخدام أكثر قليلا من الصورة الواقعية المجردة.
بدلاً من ذلك ، يجب أن تُفهم الدول ، مثل الأفراد ، على أنها عناصر فاعلة في المجتمع. لذلك يجب ألا ينظر إلى الدولة من منظور ذري ، كما يفهمها الواقعيون ، بل بالأحرى فيما يتعلق بمجتمعها المدني الخاص بها وبالدول والمجتمعات خارج حدودها.
علاوة على ذلك ، فإن عمليات العولمة ترتبط بشكل متزايد بمشاكل المجتمعات. إن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات جماعية من جانب الدول لمواجهة الأخطار الجديدة التي تتجاوز المفهوم الواقعي للأمن على أنه مجرد حماية للأراضي.
معضلات الأمن الجديدة:
إن الوعد الأساسي الذي تبديه الدول لمواطنيها هو حماية أمنهم. في الماضي ، تم تحديد الأمن بشكل ضيق من حيث الدفاع عن حدود الدولة ، وتطبيق سياسة الهجرة للحفاظ على التماسك الوطني ، وحماية المواطنين من استخدام العنف من قبل مواطنيهم ، والأجانب أو الدول الأجنبية.
وبالطبع ، فإن مدى وفاء أي دولة بمثل هذه الوعود قد تباين دائمًا بشكل كبير وفقًا لقيادتها لموارد السلطة. لقد حاصر قدر كبير من النفاق هذا الرأي الأمني. لقد افتخرت الديمقراطيات الليبرالية بحماية حقوقها ومشاركتها الشعبية داخليا ، لكن على الساحة الدولية أيدت بسعادة الدول التي تحرم هذه الحقوق من مواطنيها ، أو أنها تستغل دولا اقتصاديا حيث تكون مثل هذه الحريات في أحسن الاحوال.
من الناحية الأخلاقية ، كانت هذه الثنائية بين الشؤون الداخلية والخارجية موضع شك دائمًا. في هذا الصدد ، وفر مفهوم السيادة الديكتاتوريين حجابًا من الشرعية الدولية ، يمكنهم من خلاله "إخفاء" انتهاكات حقوق الإنسان. سمحت السيادة أيضاً للدول القوية بقبول مناسب ، حيث يمكنهم غسل أيديهم من أي مسؤولية عن محنة إخوانهم من بني البشر الذين يعانون من سوء الحظ في ولادتهم في مناطق غير مستقرة في العالم.
ومع ذلك ، فإن مثل هذه الرؤية الضيقة للأمن أصبحت زائدة عن الحاجة في مواجهة نمو العديد من المخاطر المترابطة والتي لا يمكن لدولة واحدة أن تواجهها بنجاح. وكما يلاحظ Elkins (1992: 1) ، فإننا نواجه الآن "أزمات متشابكة ذات حجم لا مثيل له".
إن الحجة الأخلاقية لمنظور عالمي للحكم يتم دمجها بشكل متزايد مع حجة تستند إلى المصلحة الذاتية. إذا تجاهلت الدول مشاكل جيرانها ، فمن المرجح أن تكون النتيجة عدم استقرار لجميع الدول. في قلب هذه المعضلات الأمنية الجديدة هي قضية عدم المساواة العالمية.
مستويات اللامساواة العالمية مدهشة. ويقدر أن 1.3 بليون شخص يعيشون في فقر مدقع ويفتقرون إلى الموارد الأساسية مثل الماء والغذاء والمأوى. لقد ازدادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في السنوات الأخيرة: حوالي 85٪ من دخل العالم يذهب إلى أغنى 20٪ ، بينما أفقر 20٪ يحصلون على 1.4٪ فقط (Real World Coalition، 1996: 41- 2).
يقع الفقر العالمي في المقام الأول في العالم النامي ويركز بشكل خاص في أفريقيا وأجزاء من آسيا. في المقابل ، في البلدان الغربية يعاني عدد هائل من الناس من زيادة الوزن وتضيع كميات هائلة من الطعام ، إما عن طريق غير قصد من قبل المستهلكين الأفراد أو عن عمد من قبل الدول والشركات التي ترغب في الحفاظ على الأسعار العالمية.
نمو وسائل الإعلام يعني أن الوعي بهذا التفاوت يتزايد بسرعة. ومع ذلك ، فإن وسائط الإعلام ، مثل المجاعة ، كما حدث في السودان في صيف عام 1998 ، غالبا ما تصورها وسائل الإعلام بأنها كوارث طبيعية وبالتالي لا يمكن تجنبها. هذا يخفي الأسباب الإنسانية لعدم المساواة. وهي تنجم في المقام الأول عن بنية نظام الدول ، التي تفضل مصالح الدول المتقدمة على مصالح الدول النامية. هناك سبب وجيه للتفكير ، مع ذلك ، وهو أن الغرب لم يعد يظل مرتاحًا بشأن هذه المشكلة.
إن التفاوت العالمي له عواقب تؤثر على الدول الغنية والفقيرة. وأحد أكثر هذه المشاكل إثارة هو الانفجار في أعداد اللاجئين الذين يبحثون عن ملاذ آمن من بلدانهم التي تعاني من الفقر والتي مزقتها الحروب. حددت الأمم المتحدة (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، 1997: 2) ما مجموعه 13.2 مليون لاجئ في يناير 1997 ؛ ملايين آخرين كانوا ضحايا التشريد القسري داخل بلادهم.
لقد نما هؤلاء "اللاجئون الداخليون" بشكل هائل نتيجة التطهير العرقي والحروب الأهلية في أماكن مثل البوسنة وكوسوفو في أوروبا والسودان ورواندا في إفريقيا. مثل هذه الأحداث تبرز نقطة ضعف أخرى في المفاهيم التقليدية للسيادة والأمن: "معظم الناس أكثر عرضة للخطر من حكوماتهم أكثر من الأجانب" (براون ، 1997: 132). لكن بالنسبة للبلدان المتقدمة ، يشكل هؤلاء اللاجئين تهديدًا محتملاً لاستقرارهم ، حيث يحاول المهاجرون السياسيون والاقتصاديون الهرب إلى دول أكثر ازدهارًا من خلال وسائل قانونية أو غير قانونية. إن تشريد الملايين من الناس من ديارهم هو أيضاً نقطة محورية من عدم الاستقرار الإقليمي قد تهدد أمن العالم على المدى الطويل.
يعني انتشار الأسلحة النووية أنه يمكن احتواء الصراعات الإقليمية بسهولة أقل. في مايو 1998 ، انفجرت الهند وباكستان عدة أجهزة نووية ، مما يشير إلى وضعهما النووي في مواجهة المعارضة العالمية ، وبدء سباق تسلح خطير بين دولتين خاضتا ثلاث حروب منذ التقسيم وتشتبك في نزاع مستمر في كشمير.
تبرز هذه الأحداث بشكل مخيف عدم قدرة حتى أقوى الدول على منع انتشار الأسلحة التي يمكن أن تؤدي إلى الإبادة لنا جميعا. في مواجهة القوة التدميرية للحرب النووية ، أصبح الاعتماد الواقعي على القوى العظمى أو التحالفات الاستراتيجية التي تقدم الاستقرار للشؤون العالمية عتيقا. حتى "الضعفاء" يمكنهم الآن تهديد بقاء الأقوياء (Bull، 1977: 48).
كما ترتبط مشاكل الهجرة واسعة النطاق وانتشار الأسلحة النووية بالجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويقول كارتر (1997) إن عدم الاستقرار السياسي في أوروبا الشرقية وأفريقيا ، ورفع الضوابط المفروضة على التجارة العالمية ، وتعقيد تكنولوجيات النقل والاتصالات هي من بين العوامل التي عانت من الجريمة المنظمة العالمية.
ينظم مجرمون منظمون للغاية مثل المافيا الإيطالية وثلاثيات الصينية تجارة مزدهرة للمهاجرين غير الشرعيين والأسلحة والمخدرات. تقدر الأمم المتحدة (1996 ب) أن عصابات الجريمة تأخذ 1000 مليار دولار سنوياً. يشكل سوق المخدرات غير الشرعية وحده 10 في المائة من التجارة العالمية ، وهو في المرتبة الثانية بعد التجارة في النفط (Real World 192 Rethinking Governance
الائتلاف ، 1996: 55). والأكثر مدعاة للقلق هو الدليل على أن الأسلحة المتطورة بشكل متزايد يتم بيعها إلى الحكومات والجماعات الإرهابية من قبل المجرمين. في يوليو / تموز 1994 ، أثناء التحقيق في عملية تزوير منظمة ، عثرت الشرطة الألمانية على خمس أونصة من البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة. تدعم هذه التطورات ملاحظة كارتر (1997: 146) بأن "قضايا الجريمة العالمية هي النوع الجديد من تهديدات الأمن القومي".
ومثل العديد من المعضلات الأمنية الجديدة ، فإن عدم المساواة العالمي هو السبب الجذري للعديد من أكثر الأنشطة الإجرامية ضرراً. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك تجارة المخدرات ، حيث يزرع المنتج الأساسي في البلدان الفقيرة للغاية مثل كولومبيا وباكستان ، حيث تكون أسعار المحاصيل الأخرى مثل الكاكاو والأرز منخفضة للغاية وبالتالي غير مربحة. يؤكد تحالف العالم الحقيقي (1996: 55) أن "قصة إنتاج المخدرات وتجارة المخدرات هي نتيجة ثانوية لفشل نظامنا التجاري الزراعي الدولي".
الفقر وعدم المساواة يزيدان أيضا من تدهور البيئة الطبيعية. وكثيرا ما ينظر إلى البلدان النامية ، التي تنظر إلى هذه المحاولات باعتبارها محاولة من جانب البلدان المتقدمة النمو لمنع تطور المنافسة ، أن محاولات فرض قيود على الإنتاج الصناعي أمر يثير الشكوك.
في المقابل ، تميل الاقتصادات المتقدمة إلى مقاومة القيود المفروضة على الإنتاج الاقتصادي على أساس أن هذه البلدان لن تنفذها البلدان الفقيرة (Elliott، 1998). ومع ذلك ، في أي منطقة أخرى هي السيادة خيالية جدا. وقد سلط كتاب مثل بيك (1992) الضوء على عدم جدلية الجغرافيا في مواجهة المشاكل البيئية مثل الاحترار العالمي واستنفاد طبقة الأوزون.
ما هو مطلوب للتصدي للأضرار البيئية ، فضلا عن المعضلات الأمنية الأخرى التي تم تحديدها هنا ، هو نهج عالمي للحكم. ومع ذلك ، يجب أن يدرك هذا أن الحكم الرشيد ممكن فقط إذا تم التعامل مع عدم المساواة العالمية. في العالم النامي ، غالباً ما تنتج ممارسات مثل إزالة الغابات وارتفاع معدلات المواليد من الفقر.
يدمر الفقراء الغابات المطيرة التي تعتمد عليها الحياة كلها ، وليس من خلال الإهمال المتعمد للبيئة ولكن من أجل كسب العيش ، في حين أن معدلات المواليد المرتفعة في العالم النامي غالباً ما تنتج عن الحاجة إلى إنشاء زوج آخر من الأيدي للمساعدة في إطعام الأسر المتعطشة للجوع. . هذه النقطة الأخيرة تطرح مسألة الديموغرافيا.
كان النمو السكاني مصدر قلق منذ القرن الثامن عشر على الأقل. ما هو جديد ، ومع ذلك ، هو كثافة هذا النمو في أواخر القرن العشرين. في عام 1990 ، كان عدد سكان العالم 5.3 مليار نسمة ؛ بحلول عام 2100 ، من المقدر أن يكون أكثر من 10 مليار (كينيدي ، 1994: 23).
ومرة أخرى ، فإن ما يثير الاهتمام في هذه المشكلة هو صلتها بعدم المساواة العالمية: حيث أن 95 في المائة من النمو السكاني في العالم النامي. يرتبط هذا النمو ، ليس فقط بالفقر المادي ، ولكن أيضًا بنقص التعليم والحصول على وسائل منع الحمل. هذا العامل الأخير يثير قضية حقوق المرأة ، وبشكل أعم مسألة حقوق الإنسان برمتها.
كانت سيادة الدولة في كثير من الأحيان عائقاً أمام تعزيز مجموعة من الحقوق الأساسية التي تتمتع بها جميع شعوب العالم. تعاني النساء بشكل غير متناسب في هذا الصدد ، حيث يمثلن 70 في المائة من فقراء العالم وثلثين من الأمّيين (Real World Coalition، 1996: 29).
ومع ذلك ، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن إنكار الحقوق مثل التعليم الأساسي وتحديد النسل للنساء في العالم النامي يساعد على تعزيز النمو السكاني ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة عدم المساواة في العالم ، ويشجع الهجرة المزعزعة للاستقرار ويغذي الجريمة عبر الوطنية.
كما يتم وضع الضغط الإضافي على الهيكل البيئي ، حيث تضطر البلدان النامية إلى محاولة تعويض هذه المشاكل من خلال السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية قصيرة الأجل بدلاً من إعطاء الأولوية للتنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك ، يترافق الضرر البيئي مع الفقر وحرمان حقوق الإنسان من زيادة عدم الاستقرار في المناطق الفقيرة في العالم.
قد يكون ، على سبيل المثال ، أن العديد من النزاعات العسكرية المستقبلية ، في مناطق مثل الشرق الأوسط ، سوف تتضمن صراعات على الوصول إلى الموارد الأساسية مثل المياه (إليوت ، 1998: 224). كما أن النمو السكاني له آثار على مستويات البطالة العالمية ، التي تقدر منظمة العمل الدولية أنها 30 في المائة من القوى العاملة في العالم في كانون الثاني / يناير 1994 ، وهي مصدر آخر لعدم الاستقرار السياسي (تشومسكي ، 1997: 188).
إن الطبيعة المتداخلة لهذه المعضلات الأمنية الجديدة ، التي تم إبراز بعضها فقط هنا ، لا يمكن فهمها من خلال الافتراضات الإحصائية لنظرية العلاقات الدولية التقليدية. لهذا السبب ، قام كتاب مثل مارتن شو (1994) بتطوير علم اجتماع سياسي للسياسة العالمية.
يتناول شو عدم وجود مفهوم للمجتمع في نظرية العلاقات الدولية من خلال توسيع مفهوم العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني إلى المجال العالمي. وهكذا يحدد شو ظهور الدولة العالمية (وهو مصطلح يستخدمه Shaw للإشارة إلى تطور الحوكمة العالمية) وإلى مجتمع مدني عالمي ، ويحلل هذه الأمور فيما يتعلق بما يسميه بعد النزعة العسكرية.
يمكن العثور على بدايات إنشاء "دولة" عالمية في مؤسسات مثل الأمم المتحدة ، بينما يمكن اكتشاف مجتمع مدني عالمي جنيني في تطوير الحركات الاجتماعية العالمية ، وأنشطة الشركات متعددة الجنسيات (MNC) وفي النمو الوعي بالمخاطر العالمية. إن مفهوم ما بعد النزعة العسكرية مهم بطريقتين.
أولاً ، هذا لا يعني نهاية التهديدات العسكرية في حد ذاتها ، ولكنه يستلزم الاعتراف بأن معظم القضايا الأمنية التي تواجهها الدول الآن ليست ذات طبيعة عسكرية مباشرة ، ولكنها تنطوي على قضايا عابرة للحدود مثل عدم المساواة والهجرة والأضرار البيئية.
ثانياً ، مجتمع ما بعد الحرب هو مجتمع تكون فيه المواطنة منفصلة عن ارتباطها الوثيق بالواجب العسكري. مع الطبيعة التكنولوجية المتنامية لأنظمة الأسلحة ، من غير المرجح أن تكون جيوش التجنيد الجماعي سمة من سمات النزاع المسلح في المستقبل. ويسمح هذان الجانبان من نزعات ما بعد النزعة العسكرية ، على الأقل ، بإمكانية فك الارتباط بين المواطنة والدولة ، وتشجيع أخلاقيات المسؤولية العالمية لمواجهة التحديات التي تشكلها التهديدات العالمية. قد يساعد "نزع سلاح" المواطنة أيضًا على تشجيع الأساليب السياسية بدلاً من العنف للتوفيق بين الاختلافات على مستوى العالم.
بعد أن حددت الحاجة الملحة للحوكمة العالمية ، وحددت بعض الاتجاهات التي قد تعززها ، يتعين عليها في القسم 1 التالي استكشاف مدى تطورنا الفعلي.
نحو إدارة عالمية:
في مايو 1998 ، اجتمعت مجموعة الثماني في برمنجهام (إنجلترا) لمناقشة سلسلة من المشاكل العالمية الملحة ، عكست الكثير منها المعضلات الأمنية الجديدة المذكورة أعلاه. وشملت النقاط الرئيسية للمناقشة تنفيذ اتفاق كيوتو لعام 1997 (الذي يهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة) ، ومشكلة البطالة العالمية ، وتعزيز التنمية المستدامة وإدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي ، والحاجة إلى إصلاح البنية المالية العالمية للتعامل مع مثل هذه الأزمات مثل انهيار العملات الآسيوية التي بدأت في عام 1997 ، وإدانة التجارب النووية الأخيرة في الهند (الجارديان ، 1998 ب).
وتوضح الطبيعة العالمية لهذه المشاكل الحاجة المتزايدة إلى استجابة دولية متماسكة. ومع ذلك ، في غياب حكومة عالمية ، يعتمد نجاح الحكم العالمي بشكل أساسي على التعاون بين الدول.
ومع ذلك ، فإن مؤسسة مجموعة الثماني هي في حد ذاتها مثالاً على الطبيعة غير الديمقراطية وغير الخاضعة للمساءلة للعديد من مؤسسات الحكم الدولي ، التي تسيطر عليها دائماً النخبة من البلدان الغربية. وبالتالي ، فالمبادئ التي تقود الحوكمة العالمية لم تكن مفاجئة على وجه الخصوص مبادئ الليبرالية الجديدة وسيادة الدولة.
ومع ذلك ، من الواضح ، كما يقول شو (1994: 21) ، أنه حتى الدول القوية بدأت في إدراك حدود سيادتها وسعت إلى تعاون أكبر مع الدول الأخرى. على الرغم من أن الواقعيين على حق في تحديد درجة عالية من المصلحة الذاتية التي تدفع هذه التطورات ، في الواقع ، كما سبق أن أشرنا ، فإن الانقسام بين المصلحة الذاتية والأخلاق هو بشكل زائف بشكل متزايد.
وكلما أدركت الدول أن النهج العالمي للمشاكل العالمية هو الأكثر احتمالا لتأمين النظام ، وأن هذا النظام يجب أن يرتكز على أخلاقيات العدالة والمسؤولية المشتركة ، كلما زاد احتمال رؤيتنا تنوع مؤسسات الحكم. هذه العملية جارية بالفعل وتتضح من نمو المنظمات الدولية وظهور مجتمع مدني عالمي جنيني.
ومع ذلك ، لا يمكننا ببساطة أن نرسم مسارًا واضحًا من الحكم الذي يتمحور حول الدولة إلى نوع جديد من الحوكمة على المستوى العالمي. وقد تطورت هذه المنظمات والجهات الفاعلة إلى حد كبير بطريقة مخصصة ، ومليئة بالتناقضات ، وغالباً ما كانت تفتقر إلى رؤية للحوكمة تتجاوز مكاسب المدى القصير وإدارة الأزمات.
الأنظمة الدولية:
لطالما كانت المنظمات الدولية سمة من سمات السياسة العالمية. أمثلة من الماضي تشمل "حفلة أوروبا" ، التي تشكلت بعد هزيمة نابليون ، وعصبة الأمم ، التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى. ومع ذلك ، كان المشاركون في هذه المنظمات دولًا ثابتة. وبالمقابل ، يشير المفهوم الحديث لنظام دولي إلى شكل من أشكال الحكم ، التي تهيمن عليها الدول على الرغم من كونها متعددة الأطراف في تكوينها وتنطوي على دور استشاري للمجتمع المدني العالمي. بالنسبة لليبراليين ، فمن خلال هذه المؤسسات الحكومية يمكن تنظيم مشاكل العالم دون اللجوء إلى تغييرات جذرية في النظام الدولي (Hurrell، 1995: 61-4).
النظام الأهم "يدير" الاقتصاد العالمي. توجد مجموعة كبيرة من المنظمات لمراقبة وتعزيز التجارة والاستقرار المالي. لقد تم ذكر مجموعة الثمانية بالفعل ، ولكن هناك أيضا البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية (WTO) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
على الرغم من أن هذه المنظمات تتمتع باستقلال معين عن الدول ، وتتفاعل مع الجهات الفاعلة من غير الدول مثل الشركات متعددة الجنسيات ، إلا أنها أقوى الدول التي توفر الروابط بينها. مجتمعة ، تشكل هذه المنظمات نظامًا للإدارة الاقتصادية (EMR) له تأثير كبير في تشكيل الاقتصاد العالمي الذي أشار إليه أحد المعلقين باسم "حكومة العالم الفعلي" (مورغان ، استشهد به في تشومسكي ، 1997: 178). والمشكلة في إقليم شرق المتوسط هي أنها تهيمن عليها أيديولوجية الليبرالية الجديدة التي صممت من أجل تشومسكي (1997: 178) لخدمة مصالح الشركات عبر الوطنية والمصارف وشركات الاستثمار.
بالتأكيد ، يبدو أن إقليم شرق المتوسط مدفوع بمتطلبات المصالح الغربية للشركات والدولة. فقد حرصت بشدة على حقوق الغرب في الملكية الفكرية ، وبالتالي حافظت على السيطرة المتقدمة لجميع العالم المتقدم في التقنيات المتقدمة. وفي الوقت نفسه ، عززت تحرير التجارة في المناطق التي تعود بالفائدة على العالم المتقدم النمو. توضح محاولتان أخيرتان للتحرير الدوافع الكامنة وراء الـ EMR وتضفي الثقل على حجج النقاد مثل تشومسكي.
أولاً ، يجادل ويد و Venerovo (1998) بأن رد فعل الغرب على الأزمة المالية الآسيوية ، التي شهدت هبوطاً حاداً في قيمة العملة والسهم في بلدان مثل سنغافورة وإندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان في 1997-8 ، كان في غير محله و النصر. هددت هذه الأزمات بإرسال المنطقة ، إن لم يكن العالم ، إلى الركود.
ومع ذلك ، كان رد فعل إقليم شرق المتوسط هو محاولة فرض دول مثل كوريا الجنوبية ، من خلال شروط صارمة يتم وضعها على حزم "الإنقاذ" المالية ، لاعتماد نظام الليبرالية الجديدة للتحرير المالي ، على الرغم من حقيقة أنه كان عدم وجود تنظيم فعال في هذا وغيرها من قطاعات الاقتصاد التي تسببت في مشاكل في العديد من البلدان الآسيوية في المقام الأول (فايس ، 1998: الحادي عشر-الخامس عشر).
بالنسبة لـ Wade و Venerovo (1998: 19) ، تعكس مثل هذه التكتيكات الصراع المستمر بين الأنظمة الاقتصادية المتنافسة ، حيث تسعى EMR إلى "إقامة نظام عالمي لحركة رأس المال" لصالح الاقتصاد الليبرالي الجديد الذي يهيمن عليه الأمريكيون. النظام.
ثانياً ، سعى إقليم شرق المتوسط إلى تحرير الاستثمار الأجنبي بطريقة أكثر درامية من خلال الترويج للاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن الاستثمارات (MAIs). وقد نوقشت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأول مرة في عام 1995 ، ولكنها توقفت في عام 1998 ، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضغوط جماعات البيئة ومخاوف بعض الدول النامية.
وقد تم استدعاء MAIs "وثيقة حقوق" MNCs (أصدقاء الأرض ، 1998). وسوف "يجرد الدول من قوتها للتغطية ضد الاستثمارات الأجنبية غير المستدامة ويعطي الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين الآخرين حقوقًا غير مسبوقة" (Friends of the Earth ، 1998). إذا تم تنفيذ هذه الاتفاقيات ، فستحول ميزان القوى بين الدول النامية والشركات متعددة الجنسيات بثبات في اتجاه الأخير.
ولن تتمكن الدول من التمييز ضد الشركات الأجنبية ، ومن ثم ، قد تحول مؤسسات الحكم الذاتي الكبرى دون تطوير المشاريع المحلية الصغيرة في البلدان الفقيرة ، مما قد يوفر الطريق الواقعي الوحيد للتنمية المستدامة. ويخشى أيضا أنه ، في إطار الوزارة ، ستعفى الشركات الأجنبية من التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وحماية المستهلك. كما أعربت الحركات الاجتماعية عن قلقها بشأن ضعف التنظيم البيئي ، فضلاً عن الآثار السلبية للـ MAIs من أجل الديمقراطية.
إن إقليم شرق المتوسط هو نموذج نموذجي لفشل الدول القوية في النظر إلى أبعد من مصالحها الخاصة الضيقة ، وإصلاح هذه الأنظمة واستخدامها من أجل الحكم الفعال على كوكب الأرض. على وجه الخصوص ، أدت هيمنة الفكر الليبرالي الجديد في السياسة الاقتصادية إلى منع الإدارة الناجحة للعديد من نقاط التوتر داخل النظام العالمي مثل أزمة الديون ، والبطالة في العالم ، وعدم الاستقرار في الأنظمة المالية العالمية والأضرار البيئية. كذلك أثارت الطبيعة النخبوية وغير الديمقراطية لهذه الأنظمة أسئلة حول حقهم في حكم أي جانب من جوانب الشؤون العالمية.
الامم المتحدة:
تقدم الأمم المتحدة المزيد من المواد الخام الواعدة التي يمكن من خلالها بناء نظام للحوكمة العالمية أكثر من الأنظمة الدولية الأخرى. ويرجع ذلك في جزء منه إلى كونه الهيئة الدولية الوحيدة التي تتمتع بعضوية عالمية تقريبًا في دول العالم (Bailey and Daws، 1995: 109).
لدى الأمم المتحدة ، على النقيض من معظم المنظمات الدولية الأخرى ، عنصر تشاركي مهم لها. تعمل الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبدأ صوت واحد في الولاية ، ولجميع الأعضاء فرصة التعبير عن رأيهم في الشؤون العالمية. ومع ذلك ، فإن الأمم المتحدة هي مؤسسة متناقضة ترمز بشكل متزايد إلى الاتجاه غير المؤكد للحوكمة العالمية.
فمن ناحية ، يعزز ميثاق الأمم المتحدة مبدأ سيادة الدولة. تلزم المادة 2 (7) الأمم المتحدة بعقيدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ويهيمن عليها مجلس الأمم المتحدة الأكثر أهمية ، وهو مجلس الأمن ، أعضاءه الخمسة الدائمون: الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.
ويعكس هيكلها المتمحور حول الدولة هدف الأمم المتحدة الأولي والأولي لتوفير وسيلة يمكن من خلالها التعامل مع العدوان العسكري من قبل دولة ضد دولة أخرى بشكل جماعي. من ناحية أخرى ، من المحتمل أن تكون الأمم المتحدة مدمرة لنظام الدول من خلال دورها كداعم لحقوق الإنسان ، وهو ما يكرسه إعلانها العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
أصبح التوتر بين هذه الجوانب المتناقضة للأمم المتحدة أكثر وضوحًا في التسعينيات بسبب التغيرات في طبيعة السياسة العالمية. وضعت الحرب الباردة الأمم المتحدة بفعالية في سترة مباشرة لأن الدول الرأسمالية الغربية أو القوى الشيوعية ستستخدم حق النقض لمعارضة قرارات الطرف الآخر.
مع انهيار الشيوعية ، انخفض استخدام حق النقض من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بشكل كبير ، ووضعت الفرصة لأن تلعب الأمم المتحدة دورا أكثر استباقا في الشؤون العالمية. في الآونة الأخيرة ، كثفت الأمم المتحدة عملياتها في المناطق التي تشوه التمييز بين تعزيز حقوق الإنسان واحترامها المفترض لسيادة الدولة.
منذ عام 1990 ، غامر الأمم المتحدة في منطقة غير مشمولة بشكل واضح في ميثاقها. وعلى وجه الخصوص ، قامت بتطوير دور جديد في عمليات حفظ السلام في بلدان مثل الصومال ويوغوسلافيا ، التي مزقتها الحروب الأهلية. ومع ذلك ، لم يذكر حتى مفهوم حفظ السلام في وثيقة تأسيس الأمم المتحدة.
حتى أن مذهب حفظ السلام الجديد هذا قد امتد إلى التحرك غير المسبوق المتمثل في إنشاء ملاذات آمنة في شمال العراق في عام 1991 لحماية الشعب الكردي الذي عانى من الاضطهاد على يد حكومة صدام حسين (Luard with Heater، 1994: 180-1 ).
تعكس عقيدة حفظ السلام واقع المعضلات الأمنية الجديدة ، التي تنطوي على نحو متزايد على تطوير تهديدات للسلام داخل حدود الدولة. ومع ذلك ، فإن الأمم المتحدة تعاني من دورها الجديد بعدد من القيود. على وجه الخصوص ، تعاني الأمم المتحدة من أوجه القصور في شرعيتها ومواردها.
المشكلة الرئيسية في مفهوم حفظ السلام هي أنها طبقت بشكل انتقائي. إن قرارات الأمم المتحدة التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إندونيسيا في تيمور الشرقية وإسرائيل في فلسطين قد تم نقضها باستمرار من قبل أعضاء مجلس الأمن.
إن الشك في أن الأمم المتحدة لن تتصرف إلا عندما تخدم مصالح أقوى الدول تزداد عندما تتصرف دول مثل الولايات المتحدة من جانب واحد ، كما هو الحال في غزوها لبنما في عام 1989 ، والتي أدانتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها " انتهاك صارخ للقانون الدولي واستقلال وسيادة ووحدة أراضي الدول "(تشومسكي ، 1997: 12-13).
كما أن شرعية الأمم المتحدة محل شك حول تكوين مجلس الأمن. ويمكن تخفيف هيمنة الغرب على المجلس بزيادة عدد الأعضاء الدائمين ، من خلال إشراك ممثلين من العالم النامي: وغالباً ما يشار إلى نيجيريا والبرازيل والهند على أنها احتمالات.
ومع ذلك ، وبشكل أكثر جوهرية ، تحتاج الأمم المتحدة إلى معالجة الطبيعة المتغيرة للمسائل الأمنية وإعادة كتابة ميثاقها لتحديد أهدافها بوضوح. بالنسبة لبعض المعلقين ، يجب أن تشتمل عملية إصلاح الأمم المتحدة على دور أكبر للمجتمع المدني العالمي.
تم تقديم مقترحات لإنشاء منتدى للمنظمات غير الحكومية ، أو حتى نوع من الجمعية الشعبية المنتخبة ديمقراطياً ، للعمل جنباً إلى جنب مع الجمعية العامة: سيكون لهذه الهيئة المنتخبة دور استشاري على الأقل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة (لجنة الحوكمة العالمية). 1995: 258 ؛ Held، 1995: 273).
لم يقابل النمو الهائل في أنشطة الأمم المتحدة زيادة في التمويل من الدول الأعضاء. في الواقع ، أخفقت بعض الولايات ، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ، في تسديد مساهماتها في ميزانية الأمم المتحدة: ففي آب / أغسطس 1997 ، استحقت الولايات المتحدة 1.4 مليار دولار (الأمم المتحدة ، 1997 ب). تم حجب هذا لأسباب مشكوك فيها إلى حد ما.
على سبيل المثال ، أشار الجمهوريون الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ إلى دعم الأمم المتحدة للإجهاض ، الذي تمت الدعوة إليه في بعض الظروف كجزء من جهود الأمم المتحدة للتصدي للانفجار السكاني العالمي ، كسبب لعدم الدفع (Keesings، 1998: 42167).
كما تفتقر الأمم المتحدة باستمرار إلى الموارد البشرية اللازمة للقيام بأنشطتها في مجال حفظ السلام. في أعقاب فشل عمليات حفظ السلام في ولايات مثل الصومال ، تتردد الحكومات في ارتكاب موظفيها خوفا من وقوع إصابات ، وهو ما قد يضر بشعبيتها في الداخل. وبالفعل ، أعلن الرئيس كلينتون في أيار / مايو 1994 أن الولايات المتحدة لن تشارك إلا في عمليات الأمم المتحدة التي تشارك فيها مصالحها (Pugh، 1997: 146).
إذا كان لحفظ السلام للأمم المتحدة أن يكون قابلاً للتطبيق ، فقد يكون من المطلوب إنشاء قوة رد سريع مستقل ، تتكون من متطوعين من الدول الأعضاء. وهذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من وقت رد فعل الأمم المتحدة على الأزمات الدولية ، التي تميل إلى أن تكون بطيئة وقلبية القلب. في عام 1994 ، على سبيل المثال ، قرر مجلس الأمن بالإجماع أنه يجب إرسال 5500 جندي إلى رواندا ، ولكن الأمر استغرق ستة أشهر لتزويد الدول الأعضاء بالقوات (الأمم المتحدة ، 1997 أ).
مثل هذه القوة الدائمة ستساعد أيضا في حل مشاكل هياكل القيادة وصنع القرار الاستراتيجي ، عندما يتم وضع قوات الأمم المتحدة في الميدان. في الماضي ، كان الأمر معقدًا بسبب إحجام الدول عن وضع قواتها تحت القيادة المباشرة للأمم المتحدة (روغي ، 1998: 253-5).
تقدم الأمم المتحدة نقطة محورية مهمة للحكم العالمي وقد حققت بعض النجاحات الملحوظة في استعادة الاستقرار في بلدان مثل كمبوديا وأنغولا في التسعينات (Ratner، 1997). إن الإصلاحات لميثاقها ، وترشيد تنظيمها ، ستساعد بلا شك على تحسين تماسكها وربما تشجع الدول على دفع مساهماتها المالية المستحقة.
ومع ذلك ، فإن الدور المستقبلي للأمم المتحدة سيتم تحديده قبل كل شيء بإرادة الدول ، وعلى وجه الخصوص تصور الولايات المتحدة لقدرتها الخاصة على التعامل مع المعضلات الأمنية الجديدة المحددة في هذه المقالة.
في حين أنه قد يكون صحيحًا أنه بالنسبة للولايات الأخرى ، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ، باقتصادها القوي ومجموعة واسعة من المعدات العسكرية ، أقوى من أي وقت مضى ، ومن الصحيح أيضًا أنه في المناطق الأمنية المهمة ، تكون جميع الولايات في وضع ضعيف. وبالتالي سوف نحتاج إلى البحث عن طرق تعاون أكثر نجاحًا في المستقبل.
الإقليمية:
هناك طريقة أخرى تحاول فيها الدول إدارة عدم الأمان العالمي من خلال تعاون أكبر مع جيرانها الإقليميين. تم إنشاء منظمات مثل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ، جزئيا ، لمحاولة تشغيل نهج جماعي أكثر للصراعات العسكرية الإقليمية.
ومع تسليم الأمم المتحدة المسؤولية عن عملياتها في البوسنة إلى الناتو في عام 1995 ، والإعلان عن الرغبة في علاقة أكثر تكاملاً مع الهيئات الإقليمية ، يبدو أن المنظمات الأمنية الإقليمية سيكون لها دور أكبر في الحفاظ على النظام الدولي في المستقبل (Henrikson، 1995: 124).
ومع ذلك ، فإن مدى قدرة العالم على الاعتماد على الحلول الإقليمية محدود بسبب التوترات العسكرية الموجودة داخل المناطق ، والخوف من سيطرة مهيمن إقليمي واحد على الشؤون الإقليمية ، وصعوبات التوصل إلى اتفاق بين الجيران حول كيفية حل قضية معينة., and, most importantly, the relative lack of military power in many regions of the world, such as Africa (Fawcett and Hurrell, 1995: 316).
Of perhaps greater significance than regional security arrangements has been the growth of trading blocs such as the European Union (EU), the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the Asia-Pacific Economic Co-operation Forum (APEC). The number of such agreements has grown enormously in the post-war period: between 1948 and 1994, 109 were signed (Dicken, 1998:102).
On the question of the significance of regionalism for global governance, a number of possible interpretations have been advanced. The most persuasive view, expressed by Gamble and Payne (1996: 248), is that regionalism is as an aspect of, rather than a reaction against, political globalisation.
Despite the great variety of forms that regional organisations have taken, they have all conformed to the global movement towards economic liberalisation, driven by the EMR. There is, so far, little evidence to suggest that regionalism will entail increased economic protectionism and in that way exacerbate tensions between the three power centres of East Asia, Europe and the USA.
على أي حال ، تفتقر معظم الاتفاقيات الإقليمية إلى مستوى المؤسسات اللازمة لتنفيذ اللوائح الاقتصادية الشاملة. وبدلاً من ذلك ، فإن التحول الإقليمي ينطوي على تعاون الدول لإنشاء إطار عمل إقليمي لشركاتها للعمل فيها ، وحيثما أمكن ، لاستغلال وفورات الحجم وتعزيز تنسيق حرية حركة رأس المال والخدمات والعمالة.
في بعض المناطق ، تؤدي التوترات بين الدول إلى تقويض إمكانات الحكم الإقليمي الأوسع. في شرق آسيا ، يحد وجود قوتين إقليميتين متنافستين ، اليابان والصين ، فضلاً عن النزاعات المستمرة بين الدول الأخرى داخل المنطقة ، من مدى إمكانية إنشاء هوية إقليمية قريبة (Brook، 1998: 244).
كما أن التفاوتات الهائلة في القوة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تجعل من غير المحتمل أن يتم تشكيل تعاون أكثر شمولاً داخل نافتا في المستقبل القريب. علاوة على ذلك ، فإن أحد الأسباب التي أشارت إلى إنشاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) هو أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتقدت أنها ستكون وسيلة مفيدة لإقناع الدول الأخرى بالتوافق مع الاقتصاد الليبرالي الجديد على نطاق عالمي (Wyatt-Walter، 1995: 85).
والمنظمة الإقليمية الوحيدة التي حققت تقدمًا كبيرًا خارج نطاق تيسير التجارة الحرة هي الاتحاد الأوروبي. ما هو مهم في الاتحاد الأوروبي هو أنه أنشأ هيئات حقيقية فوق وطنية. تمتلك المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي سلطات مهمة تؤثر على حكم الدول الأعضاء.
هذا الأخير مهم بشكل خاص ، لأنه منظم على أساس ديمقراطي. لا يزال مجلس الوزراء هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الاتحاد الأوروبي وتسيطر عليه الحكومات الوطنية. ومع ذلك ، فإن عدد مجالات السياسة التي تتخذ فيها القرارات في المجلس على أساس تصويت الأغلبية المؤهلة قد نما بشكل كبير بعد التوقيع على القانون الأوروبي الموحد في عام 1986.
من خلال أحكام معاهدة ماستريخت لعام 1992 ، أنشأ الاتحاد الأوروبي عملة أوروبية واحدة (1999) وهذا سوف يستلزم بالضرورة وجود اتحاد سياسي أكبر مع إمكانية تطبيق سياسات ضريبية وإنفاق مشتركة (البارون ، 1997: الفصل 7).
من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لديه إمكانات أكبر للتطور إلى هيئة حكومية حقيقية تتجاوز الدولة مما تفعله جميع الاتفاقيات الإقليمية المعاصرة الأخرى. ومع ذلك ، فإن عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي ينبغي أن يتخذه الاتحاد الأوروبي يعكس صعوبات الحوكمة الإقليمية على نحو أعم.
على الرغم من الطبيعة الديمقراطية للبرلمان الأوروبي ، كانت أولويات الاتحاد الأوروبي هي أولويات النخب الوطنية: فقد تم تحديد أولويات تحرير التجارة على حقوق العمال والبطالة ؛ الاتحاد الأوروبي النقدي ، بدلا من الدمقرطة في الاتحاد الأوروبي وقد أعطيت سابقة. وقد خلقت السياسات تجاه كل من الدول النامية خارج أوروبا وعمال "الضيوف" غير الأوروبيين في أوروبا الخوف من وجود دولة عظمى أوروبية تكون حصرية وتمييزية مثل أي دولة قومية.
إن فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على سياسة مشتركة تجاه المشاكل الإقليمية مثل أزمة يوغوسلافيا أو مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أجزاء من أوروبا الشرقية ، يوضح أيضًا عدم وجود هوية أوروبية مشتركة أو ثقافة سياسية مشتركة (Faulks، 1998). 187-97).
بشكل عام ، كانت الهمة الإقليمية مدفوعة بمصالح النخب الحكومية وكانت مهتمة بشكل كبير بالتحرير الاقتصادي. إن أعمال الشغب العنيفة في المكسيك وصعود السياسيين الشعبويين مثل روس بيرو في الولايات المتحدة الأمريكية التي رحبت بتوقيع اتفاقية نافتا ، تعمل على توضيح الاغتراب الذي شعر به العديد من المواطنين العاديين تجاه مثل هذه الاتفاقات غير الديمقراطية. وعلى هذا النحو ، فمن غير المحتمل أن تكون المنظمات الإقليمية قادرة على تشكيل كتل البناء الديمقراطية للنظام الفيدرالي للحكم العالمي. هناك سيناريو أكثر احتمالا يعبر عنه فاوست وهوريل (1995: 327) يكتبان "في أفضل الأحوال يمكن القول إن الإقليمية قد تشكل واحدة من الأركان العديدة التي تدعم النظام الدولي المتطور".
المجتمع المدني العالمي:
غالبا ما يعلق المدافعون عن الحكم العالمي آمالهم على تنمية المجتمع المدني العالمي بقدر ما يعلقون على تشكيل المنظمات الدولية. المؤسسات الهامة للمجتمع المدني العالمي الناشئة تشمل وسائل الإعلام والشركات المتعددة الجنسيات.
لقد ساعد الإعلام الجماهيري في جعل الرأي العام عاملاً مركزياً في تشكيل تصرفات الدول الديمقراطية على الساحة العالمية ، كما يشهد على ذلك الجزء الهام الذي لعبته وسائل الإعلام في تشجيع التدخل الإنساني من جانب الدول الغربية في أزمة الصومال والبوسنة في أوائل التسعينيات. عموما ينظر إلى الشركات المتعددة الجنسيات أكثر سلبا.
وكثيراً ما تم تحليلها من حيث صراعاتها مع الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني ورموز للحاجة إلى حوكمة عالمية معززة لإدارة الآثار الجانبية التي غالباً ما تكون ضارة للرأسمالية غير المنظمة (Sklair، 1995). وهكذا ، تتعارض الشركات المتعددة الجنسيات مع نقابات العمال بشأن البطالة التي تنتج عن نقل الإنتاج إلى مواقع أرخص وأقل نقابية ، وكذلك مع مجموعات بيئية تتعلق بالنفايات السامة التي يتم التخلص منها في البلدان النامية ، كما هو الحال في الماكيلادوراس ، هي مصانع تجميع تصدير ، أنشأتها الشركات المتعددة الجنسيات الغربية على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لتجنب التنظيم الاقتصادي والبيئي (دواير ، 1994: 4-5).
ومع ذلك ، فإنه على المنظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية) أن معظم النقاش حول المجتمع المدني العالمي قد ركز. من حيث الأعداد الهائلة ، نمت المنظمات غير الحكومية بسرعة في السنوات الأخيرة. في عام 1909 كان هناك حوالي 109 منظمة غير حكومية تعمل في ثلاثة بلدان على الأقل ؛ بحلول عام 1993 كانت أعدادهم 28900 (لجنة الحكم العالمي ، 1995: 32). إن النمو في تكنولوجيا الاتصال والانفتاح النسبي لسياسات ما بعد الحرب الباردة قد سهل هذا النمو.
وتشمل الأمثلة على المنظمات غير الحكومية المجموعات البيئية ، مثل الصندوق العالمي للحياة البرية ، ومنظمة السلام الأخضر ، وجماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ، والمنظمات المعنية بالتخلف والفقر ، مثل منظمة كريستيان أيد وأوكسفام (انظر الإطار 10-1).
هدفهم المشترك هو هدف إنساني ، يهدف إلى تعزيز بيئة صحية للسلام والحياة المستدامة. لقد كانوا يميلون إلى أن يكونوا غير هادفين للربح وأن يبقوا بعيدين عن الدولة. وبالفعل ، فقد قيل إن "نشاط المنظمات غير الحكومية يمثل أخطر تحد لمقتضيات الدولة في مجالات السلامة الإقليمية والأمن والحكم الذاتي والإيرادات" (Fernando and Heston، 1997: 8).
تمتلك المنظمات غير الحكومية قوة تواصلية كبيرة وقد لعبت دوراً هاماً في زيادة الوعي بأوجه عدم المساواة العالمية والأزمات الإيكولوجية وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. لقد اكتسبوا حضورًا كبيرًا في العديد من المؤتمرات الدولية ، حيث لعبوا دوراً حاسماً ، على سبيل المثال ، في مؤتمرات الأمم المتحدة حول السكان في القاهرة عام 1994 ومؤتمر بكين الدولي للمرأة في عام 1995.
وقد دعا البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية بشكل متزايد المنظمات غير الحكومية للعمل كمستشارين ومراقبين في اجتماعاتهم. من خلال مثل هذه التفاعلات مع المنظمات الدولية ، نجحت المنظمات غير الحكومية في حملتها الانتخابية من أجل تشريع متنوع مثل العقوبات الدولية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ، ومدونة سلوك لتسويق حليب الأطفال وإنشاء اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 1984 (كلارك ، 1992: 197).
الإطار 10-1 منظمة العفو الدولية: مثال لمنظمة غير حكومية:
تأسست منظمة العفو الدولية عام 1961 بعد أن كتب أحد محامي لندن ، بيتر بننسون ، إلى صحيفة الأوبزرفر لإبراز انتهاكات حقوق الإنسان في البرتغال. أدى هذا إلى إطلاق حملة أوسع نطاقاً تستهدف "سجناء الرأي" الذين سُجنوا في جميع أنحاء العالم بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية أو الاجتماعية. وقد استندت منظمة العفو في البداية إلى جهود الأفراد الأعضاء ، الذين كتبوا رسائل إلى المسؤولين في البلدان التي كان يتم فيها احتجاز هؤلاء السجناء الذين يحثون على الإفراج عنهم. وقد نمت أنشطتها في العقود الثلاثة الأخيرة وتشمل الآن الأبحاث والمنشورات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ، فضلاً عن عدد من الشبكات المتخصصة المعنية بتشجيع حقوق الإنسان في الأعمال التجارية والمهن.
بحلول التسعينيات ، كان هناك أكثر من 4000 مجموعة محلية تابعة للمنظمة ، وفي عام 1993 كان للمنظمة مليون عضو في أكثر من 150 دولة. تتمتع منظمة العفو الدولية بسمعة ممتازة في عدم التحيز ودقة معلوماتها. وهي تسعى إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وضمان محاكمات عادلة للسجناء السياسيين وإلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وإنهاء عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
بحلول نهاية عام 1997 ، كانت منظمة العفو الدولية تعمل على ما يقرب من 4000 حالة فردية من انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك ، فقد أظهر بحث أجراه الأردن ومالوني (1997) أن 72.1٪ من أعضاء منظمة العفو يشعرون بأن النشاط السياسي ليس "سبباً مهماً جداً" أو "لم يلعب أي دور على الإطلاق" في توضيح سبب كونهم أعضاءً.
بالنسبة للأردن ومالوني ، تُظهر هذه الأدلة أن المنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية ليست أمثلة على شكل "متفوق" جديد من النشاط السياسي. تبقى مثل هذه المنظمات هرمية وتنطوي على مشاركة مباشرة ضئيلة من قبل الأعضاء. ولذلك من غير المرجح أن تحل محل أشكال المشاركة التقليدية مثل الأحزاب السياسية.
المصادر: منظمة العفو الدولية (1998) ؛ الأردن ومالوني (1997)
كما تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً اقتصادياً بشكل متزايد في السياسة العالمية وتتلقى نسبة متزايدة من مساعدات التنمية العامة ، فضلاً عن الإيرادات الضخمة من المانحين من القطاع الخاص. وقد استخدمت هذه الأموال لتخفيف المعاناة على المدى القصير وعلى المدى الطويل. عملت المنظمات غير الحكومية كمصادر للائتمان والاستثمار في التنمية الريفية والحضرية.
يزعم مؤيدوهم أن حقيقة أنهم يعملون خارج الاعتبارات الجغرافية السياسية للدول الغربية وأنهم على اتصال مع القواعد الشعبية تسمح لهم بدعم البلدان النامية بشكل أفضل. وقد مكنهم حيادهم الأكبر أيضًا من العمل كوسيط بين المجتمعات في النزاع ، مثل ، على سبيل المثال ، بين الأقلية التاميلية والأغلبية السنهالية في سريلانكا (فرناندو وهستون ، 1997: 13). رغم هذه الإنجازات البارزة ، لا تخلو المنظمات غير الحكومية من منتقديها.
غالباً ما تم إنشاء المنظمات غير الحكومية من قبل شخصية كاريزمية واحدة وفشلت في وقت لاحق في بناء هياكل ديمقراطية مناسبة داخل منظمتهم. ويقال إن هذا غالبا ما يجعلها بيروقراطية مفرطة وغير خاضعة للمساءلة. هذه مشكلة خاصة بين المنظمات غير الحكومية الغربية التي تلعب دورًا تنمويًا في المناطق الفقيرة في العالم. الانطباع هو أن المنظمات غير الحكومية أبدت علاقة أبوية مع المستفيدين من مساعداتها وأنها "حريصة على تقديم الخدمات بدلاً من بناء المشاركة" (Streeten، 1997: 196).
وقد أثيرت الحجة أيضا بأن المنظمات غير الحكومية قد أصبحت أقرب تدريجيا من مصالح متبرعيها ، وبالتالي أصبحت أقل استجابة للاحتياجات الطويلة الأجل للبلدان النامية. يؤكد هولم وإدواردز أن السبب الذي جعل الدول تستفيد بشكل أكبر من المنظمات غير الحكومية منذ الثمانينيات يرتبط بهيمنة النهج الليبرالي الجديد على الحكم ، الذي يعطي الأولوية للحلول السوقية والطوعية للفقر بسبب تدخل الدولة. في الواقع ، أصبحت المنظمات غير الحكومية المتعاقدين من الباطن مع الدول و "المنفذين لسياسات المانحين" (هولم و إدواردز ، 1997: 8).
وقد سمح ذلك للدول بالانسحاب من التزاماتها تجاه المجتمع العالمي. غير أن المشكلة تكمن في أن الإجراءات غير المنسقة والمخصصة للمنظمات غير الحكومية ليست بديلاً عن الإجراءات الحكومية الجماعية للتخفيف من الأسباب الجذرية لعدم المساواة في العالم.
وتتفاقم الطبيعة غير المنسقة لنشاط المنظمات غير الحكومية بحقيقة أن اعتمادها على الجهات المانحة يدفعها للتنافس مع بعضها البعض للتمويل. وهذا يتطلب بالضرورة وجود مادي في مناطق الاضطرابات في جميع أنحاء العالم ، بحيث يمكن للمانحين أن يروا أن أموالهم تُستخدم على الفور لمعالجة أحدث مجاعة أو كارثة بيئية. ومع ذلك ، ونظراً لتعقيدات العديد من المشكلات العالمية ، فإن الاستجابة السريعة من جانب المنظمات غير الحكومية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها. ومن الواضح أن المنظمات غير الحكومية التي تتنافس من أجل التغطية في وسائل الإعلام العالمية ، من أجل طمأنة المانحين بأنها "تقوم بشيء ما" ، ليست هي النهج الأكثر إنتاجية التي يجب اعتمادها.
كما أن الحاجة إلى إظهار النتائج تعني أن عمليات الإغاثة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية موجهة ، وليس إلى الفئات الأشد فقرا ، ولكن إلى أولئك الذين يعيشون على خط الفقر ، والذين يمكن حل مشاكلهم بسهولة أكبر. وبالتالي ، فإن 80 في المائة من أفقر فقراء العالم البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة لا يزالون بمنأى عن نشاط المنظمات غير الحكومية (ستريتن ، 1997: 197).
قد تساعد المنظمات غير الحكومية أيضًا في الحفاظ على الأزمات نفسها التي تسعى إلى تخفيفها. في مناقشة لدور المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين الروانديين في منتصف التسعينات. يقول Storey (1997: 386) أن "بعض المنظمات غير الحكومية. . . تقديم الدعم لقوى نظام الإبادة الجماعية المخلوع '.
ويرجع ذلك جزئياً إلى الاختيار الذي قامت به العديد من المنظمات غير الحكومية لتركيز انتباهها على مخيمات اللاجئين في زائير المجاورة ، والتي "كانت في الغالب تحت سيطرة قوات النظام السابق ، التي كانت مسؤولة عن الإبادة الجماعية" ، وليس على المساعدات. لضحايا الحكومة السابقة داخل رواندا نفسها (ستوري ، 1997: 387).
كما أظهر العديد من المنظمات غير الحكومية سذاجة صادمة فيما يتعلق بطبيعة الصراع في رواندا وأعطت روايات غير مستنيرة عن جذور الصراع إلى وسائل الإعلام ، التي حملت بدورها رسالة مشوهة إلى الوطن. باختصار ، فإن صورة المنظمات غير الحكومية التي غالباً ما تصور نفسها على أنها "تجسيد للحركات الإنسانية غير المغرضة" (Stirrat and Henkel، 1997: 69) هي ببساطة غير مستدامة.
وعلاوة على ذلك ، فإن هذا الوهم بالحياد يساعد على إضعاف عزم المجتمع العالمي على مواجهة مثل هذه الأزمات كما حدث في رواندا باستجابة حازمة ومنسقة لا يمكن في الواقع أن تكون محايدة في أهدافها أو آثارها.
لعبت المنظمات غير الحكومية بلا شك دوراً هاماً في زيادة الوعي بالتهديدات العالمية ، لكن لا يمكن أن تكون هي الجهات الفاعلة الرئيسية في حلها. وفي بعض الحالات ، يمكن أن تدعم نواياهم الطيبة عن غير قصد المخاطر العالمية وتضعف فرص التعامل مع أسبابها الجذرية.
لذلك ، جادل كتاب مثل هولم وإدواردز (1997) بأن المنظمات غير الحكومية ستنصح بشكل جيد بتركيز جهودها على الضغط على دولهم من خلال حشد الرأي العام والضغط في المؤتمرات والمنظمات الدولية ، وتقليل أعمال الإغاثة قصيرة الأجل. حيث "بغض النظر عن الصعوبة التي يحاولون تجنبها ، يصبحون حتمًا لاعبين في عالم من المحاباة والتلاعب السياسي" (Stirrat and Henkel، 1997: 74).
من الديمقراطية الليبرالية إلى الديمقراطية الكوزموبوليتية؟
إن الاحتمالات المستقبلية لإنشاء مؤسسات الحكم العالمي المستدامة غير مؤكدة. وتعاني المنظمات الدولية القائمة من عجز ديمقراطي حاد وتحركها مصالح نخبة أقوى الدول ، في حين تفتقر الجهات الفاعلة غير الحكومية في المجتمع العالمي إلى التماسك والشرعية لممارسة الحكم بنجاح من تلقاء نفسها.
علاوة على ذلك ، أدت هيمنة الليبرالية الجديدة على الاقتصاد العالمي إلى زيادة عدم المساواة العالمية ، التي تكمن في جذور العديد من مشاكل العالم. وبالتالي ، توجد الإمكانية لردود الفعل العنيفة على أوجه عدم اليقين في عالم ما بعد الحرب الباردة. هل يمكن أن يكون ذلك ، كما حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي ، أن فشل تحرير الاقتصاد وعدم استقرار نظام الدول سيؤديان إلى تشكيل المعادلات الحديثة للفاشية والشيوعية ، حيث تسعى المجتمعات المهمشة إلى "اليقين" الأخلاقي في صورة دينية أو عرقية. الأصولية تتمحور حول الدولة العسكرية؟
من المؤكد أن العولمة السياسية كانت مصحوبة بالتجزؤ. بهذا المعنى ، نشهد طفرة في شعبية الدولة ، وليس زوالها. لقد ساعد تفكك الإمبراطورية السوفييتية ويوغوسلافيا ، وصعود الإسلام الأصولي في الشرق الأوسط والتوترات حول حدود الدولة ما بعد الاستعمارية في إفريقيا ، على جعل النضال من أجل السيطرة على الإقليم ، والطلب على الدولة سمة أساسية للمعاصرة. العالمية. وقد تقدم صموئيل هنتنغتون (1998) بتفسير مؤثر للغاية لهذه الأحداث.
يجادل هنتنغتون أنه بعيداً عن خلق مصالح مشتركة ، وبالتالي أساس للحكم العالمي ، فإن العولمة عززت بدلاً من ذلك الاختلافات الثقافية القائمة منذ زمن بعيد ، مثل بين المسيحية والإسلام. بالنسبة إلى هنتنغتون ، ستصبح الدول القومية أكثر تحديداً لمصالحها فيما يتعلق بولائها لأحد حضارات العالم العظيمة.
سوف تكون العلاقات بين هذه الحضارات "قريبة من أي وقت مضى ، وعادة ما تكون باردة ، وغالبا معادية" (هنتنغتون ، 1998: 207). القسم الأكثر أهمية هو "الغرب والباقي" (هنتنغتون ، 1998: 183). رداً على ذلك ، ينبغي للقوة الرئيسية للغرب ، الولايات المتحدة الأمريكية ، أن تتخلص من فكرة أنها تستطيع إعادة إنتاج ثقافتها على مستوى العالم ، على حساب الحضارات الأخرى ، وينبغي بدلاً من ذلك تركيز جهودها دولياً على بناء التحالفات حيثما أمكن وعلى الصعيد المحلي. حول "رفض دعوات الإنشقاق للتعددية الثقافية" ، بحيث يمكن إعادة تأكيد هويتها الغربية (هنتنغتون ، 1998: 307).
أطروحة هنتنغتون معيبة بعدة طرق. فشل في تفسير التوترات القائمة بين الدول ضمن "الحضارة" نفسها ، كما شهدها غزو العراق للكويت عام 1990 ، وعلى الرغم من اعترافه بأن الحضارات "ديناميكية" ، فإن فهم الثقافة التي تدعم أطروحته هو واحد ثابت بعد كل شيء ، ما هي الثقافة الأمريكية إذا لم تكن "متعددة الثقافات"؟
ما هو الأكثر أهمية لمناقشتنا ، مع ذلك ، هو أن وصفات هنتنغتون للسياسة هي ببساطة غير واقعية. في سياق المخاطر العالمية الموضحة في هذه المقالة ، فإن الاستراتيجية التي تدعو إلى تراجع خلف جدران الدولة للدفاع عن وهم الحضارة المشتركة ستكون كارثية. إذا كان لا بد من تجنب هذا المصير ، يجب إيجاد طريقة لإضفاء مزيد من الترابط على فكرة الحكم العالمي.
يجب الاعتراف بأن التوترات التي حددها هنتنغتون لا تكمن جذورها في عدم توافق الثقافات المتنوعة ، بل إنها ناتجة عن إهمال احتياجات معظم المجتمعات من قبل الدول القوية ، التي تعمل باسم "المصلحة الوطنية". بيد أن الحجة الأساسية لهذه المادة كانت ، مع ذلك ، بسبب الضعف المشترك للمخاطر العالمية ، أصبحت المصلحة الوطنية الحقيقية لا يمكن تمييزها عن مصالح الإنسانية ككل. وبالتالي فإن الإنكار المتغطرس لاحتياجات الآخرين سيصبح هزيمة ذاتية على نحو متزايد.
إن نظرية الديمقراطية الكونية ، التي قدمها مؤلفون مثل Held (1995) و Linklater (1998) ، هي المحاولة الأكثر أهمية لبناء نظرية الحكم العالمي. هذه النظرية مهمة جداً لعلم الاجتماع السياسي المعاصر لأنها تبرز مرة أخرى تناقضات العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وتسعى إلى استكشاف كيف يمكن للتغير الاجتماعي المعاصر أن يخلق الفرصة لتجاوزها.
لذا فإن مناقشة الديمقراطية الكوسموبوليتانية تعود بنا إلى جذور موضوعنا وشواغل مفكرها الأكثر أهمية. لأنه كان دائما نية ماركس لفهم علاقة الدولة مع المجتمع المدني حتى يوم واحد يمكن الاستغناء عن مفارقاتها.
في الختام ، سوف أعتبر كيف أن النظر في الديمقراطية العالمية يعزز فهمنا لعلاقة الدولة الإشكالية بالعنف ، والمواطنة الديمقراطية والسوق. على الرغم من أن جميع المدافعين عن الديمقراطية الكوزموبوليتية لا يقبلون تفسيري لتداعيات هذا المفهوم ، إلا أنه من الصحيح القول إن الجميع سيوافقون على أن العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني تكمن في صميم مشكلة الحكم العالمي.
الهدف الأول للديمقراطية الكونية هو البناء على تنمية المنظمات الدولية والمجتمع المدني العالمي ، وإيجاد طرق لدمج هذه العناصر معاً في نظام متماسك للحكم العالمي. وعلى النقيض من هنتنغتون ، فإن رؤية ثقافات مختلفة تكاملية أكثر من كونها تنافسية ، وإيجاد طرق يمكن من خلالها شمول الحكم العالمي من خلال عمليات الدمقرطة.
يستخدم Linklater (1998) مصطلح "النقد اللاشعوري" لوصف هذه الإستراتيجية ، لأنه يسعى إلى وضع وصفاته النظرية بثبات على التطورات في العالم الحقيقي. وكما تم التأكيد عليه في هذه المقالة ، فإن أهم قوة محفزة للحوكمة العالمية هي المخاطر العالمية ، والتي لا يمكن إدارتها بفعالية من قبل الدول التي تعمل في عزلة. على أية حال ، لا يناصر مؤيدو الديمقراطية الكوزموبوليتية إنشاء حكومة عالمية ، على شكل دولة عالمية مركزية.
في ظل الإبادة النووية ، مفهوم Westphalian من "قد يكون صحيحا" هو زائدة عن الحاجة. لذلك ، فإن إنشاء دولة عالمية من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية. وبدلاً من ذلك ، يجب حل الخلافات بين المجتمعات سياسياً حيثما أمكن ، من خلال مواقع الحكم المتعددة والمتكاملة والديمقراطية.
وهذا يعني بالضرورة دورًا أقل للعنف. وهكذا ، على الرغم من أن بعض مؤيدي الديمقراطية الكونية يسمحون باستخدام القوة كملجأ أخير ، فإن حججهم تسليط الضوء على مشكلة الدولة التي تقوم على شرعيتها على استخدام العنف. على عكس الدولة ، التي يتم تحديدها من حيث استخدام العنف ، فإن الحكم العالمي يعني استخدام القوة فقط على أساس تكتيكي ، لإزالة الحواجز التي تحول دون ترسيخ الأساليب الديمقراطية لحل النزاعات المستقبلية.
ثانياً ، الديمقراطية العالمية هي نظرية ما بعد الليبرالية. إنه يسعى إلى استخدام المفاهيم الليبرالية الرئيسية مثل المواطنة الديمقراطية وجعلها حقيقة لكل الناس ، بغض النظر عن انتمائهم لدولة معينة. وهذا يتطلب بالتالي عدم تفاهم هذه المفاهيم عن الدولة ، التي خلقت هويتها من خلال الممارسات الاستبعادية ، وممتدة إلى المستوى العالمي.
وكما يؤكد Held (1995: 228) ، ينبغي أن ينطبق القانون العالمي ، الذي يتمتع في جوهره بالديمقراطية وحقوق المواطنة ، على "المجتمع العالمي". ويكشف هذا عن نفاق الدول الليبرالية التي تطالب بالحقوق في الداخل (بالنسبة للمجموعات المتميزة على الأقل) ، لكنها دافعت عن استخدام القوة في الخارج. كما أنه يسلط الضوء على الطبيعة العلائقية لمفاهيم المواطنة والديمقراطية: ما لم يتم توسيع الحقوق المرتبطة بهذه المفاهيم على مستوى العالم ، فإنها دائمًا ما تكون جزئية وبالتالي ضعيفة.
وأخيراً ، فإن الديمقراطية الكونية تتحدى المنطق الثنائي للليبرالية ، الذي يؤكد أن السياسة يجب أن تقتصر على الدولة ، وأن المجتمع المدني يجب أن يهيمن عليه السوق. في كثير من الأحيان هذا يعني أن احتياجات السوق قد خربت الإرادة الديمقراطية.
لا يعني الاعتراف بهذه الحقيقة أننا بحاجة إلى التخلي عن السوق تمامًا. ومع ذلك ، فهذا يعني أننا نعترف بأن السوق هو خادم جيد ولكنه سيد سيء. إذا كان بالإمكان خلق حكم عالمي ذي مغزى قائم على المبادئ الديمقراطية ، "يجب ترسيخ نظام السوق في مجموعات الحقوق والالتزامات في القانون الديمقراطي" (Held، 1995: 250).
استنتاج:
من الضروري التأكيد على أن مدى الحوكمة العالمية في المستقبل سوف يعتمد إلى حد كبير على الخيارات التي تتخذها الدول. من الواضح أن المقاومة للحكم العالمي ستكون عظيمة ، ولا توجد قوى تاريخية لا مفر منها في العمل تضمن نجاحها. وعلاوة على ذلك ، فإن التطورات في الاتصالات العالمية عززت إمكانية حدوث صراع أكبر والتعاون بين مختلف شعوب العالم.
وقد ثبت في هذه المقالة ، أن المخاطر العالمية تخلق أساسا للمصالح المشتركة العالمية ، فقط في تجنب الإبادة المتبادلة من خلال الحرب ، أو الانقراض من خلال تدمير أنظمة دعم الحياة على كوكب الأرض. إن الطبيعة المتداخلة لهذه المعضلات الأمنية الجديدة ، المتجذرة في عدم المساواة العالمية وعدم استقرار نظام الولايات ، تعني أنه لا يمكن إدارتها بنجاح إلا على المستوى العالمي.
ولهذا السبب سعى علماء الاجتماع السياسيون إلى إيجاد طرق يمكن بها البناء على النمو التدريجي للمؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة لتشكيل أنظمة الحكم التي تتجاوز الدولة. إن التحدي الذي يواجه علم الاجتماع السياسي الذي تطرحه نظريات الديمقراطية الكوسموبوليتية هو أن يركز علم الاجتماع السياسي اهتمامه على التفاعلات بين المجتمعات والدول ، وكذلك على علاقات القوة الموجودة داخل الدول.
في الواقع ، يمكن فهم أي دولة واحدة فقط ضمن هذا السياق العالمي. ومع ذلك ، لا يزال هناك مكان لتحليل العلاقات الفردية بين الدولة والمدنية ، لأنه هنا سينشأ التحول إلى الحكم العالمي ، أو نقاط المقاومة فيه.
ومن ثم ، فإن استراتيجيات الدولة المختلفة للإدارة الاقتصادية والديمقراطية والمواطنة لا تقل أهمية عن أي وقت مضى: كيف تستجيب الدول للتحديات العالمية وكيف يمكن للمجتمع المدني أن يحل توترات الاختلافات الثقافية والمادية التي ما زالت تشكل أسئلة مهمة في علم الاجتماع السياسي. خلافا للإشاعة ، فإن التاريخ ليس في نهايته ، وعلم الاجتماع السياسي ، مع تركيزه الفريد على إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني ، سيكون حاسما في فهم اتجاهاته المستقبلية.